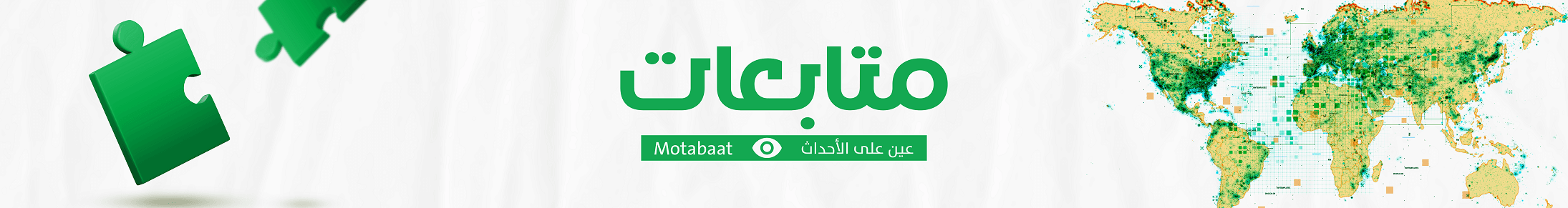«فورين أفيرز» تكشف حقيقة دور الخبراء الاستشاريين لدى حكام الخليج
نشرت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية مقالًا للكاتبة كالفيرت جونز، الأستاذ المساعد في قسم الحكومة والسياسة بجامعة ميريلاند، والتي تركز كتاباتها على السياسات المقارنة والشرق الأوسط. تناولت جونز في المقال ظاهرة الخبراء الاستشاريين الذين تستعين بهم النظم الاستبدادية في إدارة الحكم وتطوير مختلف الاستراتيجيات. وتُحذر الكاتبة في مقالها من احتمال انزلاق هؤلاء الخبراء في البيئات الفاسدة، وتحذر كذلك من خطر استغلال الزعماء لخبراتهم في تعميق انتهاكاتهم لحقوق الإنسان وقمع المعارضين.
دور وسوق متناميان
تصف الكاتبة في بداية المقال شعور الحسرة الذي عبَّر عنه أحد مطوري الأعمال السعوديين عندما سألها في عام 2016 بخصوص عشرات الاستشاريين الأجانب الذين يتقاضون أجورًا باهظة، ويهمسون في آذان زعماء بلاده، قائلًا: «هل يعرف طفل لبناني من هارفارد شوارع الرياض أكثر مما أعرفها؟».
وتؤكد جونز أنَّ هذه الظاهرة ليست فريدة من نوعها بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ولا حتى الشكوى من وجودها، مشيرة إلى قول أحد المستشارين الإماراتيين في إحدى المقابلات الصحافية: «أعينهم مسلَّطة على أموالنا. هناك الكثير من الاستراتيجيات، وما أُنجز منها ليس كافيًا».
تشير كالفيرت إلى أنَّ الخبراء يؤدون أدوارًا قيِّمة وواضحة في تقديم المشورة للقادة في الديمقراطيات الليبرالية الغنية وفي المؤسسات الدولية، لكن هناك معلومات أقل بكثير عما يفعلونه مع الأنظمة الاستبدادية والبلدان النامية ومدى تأثيرهم. ووصفت ذلك الأمر بأنه «معضلة»؛ لأنَّ الزعماء المستبدين بدءًا من الصين وصولًا إلى السعودية يعتمدون بشكل متزايد على الخبراء، وخاصة الخبراء القادمين من شركات الاستشارات الكبرى، والجامعات، والمؤسسات البحثية في الغرب.
ولفتت إلى أنَّه في عام 2017، وصل سوق الاستشارات في دول الخليج إلى 2.8 مليار دولار، ومثلَّت السعودية ما يقرب من نصف هذا المبلغ، وفقًا لإحصاءات شركة سورس جلوبال ريسيرش، مشيرة إلى أنَّه في بعض الأحيان بدا أنَّ الخبراء والمؤسسات الذين يعملون لديها غير مستعدين للتعامل مع المخاطر المحتملة للعمل في بيئة النظم السُلطوية.

وبحسب الكاتبة فقد كان الخبراء الذين يساعدون الأنظمة المعروفة بانتهاكات حقوق الإنسان وانتشار الفساد وغير ذلك من الأفعال الشائنة، وغالبًا ما يتقاضون أجورًا باهظة، في الأشهر الأخيرة محل انتقادات علنية متزايدة، سواء في الولايات المتحدة، حيث يوجد الكثير منهم، أو في البلدان التي يعملون لحسابها.
وبرهنت الكاتبة على ذلك بالإشارة إلى أن شركة ماكنزي، الرائدة عالميًا في مجال الاستشارات الإدارية، سنجد أنَّ الشركة، من بين شركات أخرى في هذا القطاع، تخضع للتدقيق والتمحيص بسبب عملها مع الحكومات والمؤسسات المملوكة للحكومات المشكوك في سمعتها، مضيفة أنَّه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أصدرت الشركة بيانًا ذكرت فيه أنَّ أحد التقرير الذي أصدرته حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية ربما يكون قد استخدمه النظام في الرياض لاستهداف المعارضين السياسيين ووصفته بالأمر «المروع».
وقبلها ببضعة أشهر في جنوب أفريقيا تورطت الشركة في فضيحة فساد سياسي كبرى، وفي أعقاب ذلك اعترفت الشركة بأنَّها بالغت في تقاضي الأموال من شركة الكهرباء المملوكة للدولة «إسكوم»، وفشلت في فحص وتقييم أحد شركائها كما ينبغي.
ووافقت شركة ماكنزي في النهاية على سداد ما يعادل 74 مليون دولار لحكومة جنوب أفريقيا، واعتذرت في بيان علني لشعب جنوب أفريقيا، وأقرت فيه بخطئها قائلة: «لم نكن منتبهين بما فيه الكفاية للشراكات التي عقدناها، ولم نفهم كليًا طبيعة الأجندات التي يتبنونها».
هل هناك مكان للمستشارين في النظم الاستبدادية؟
وترى الكاتبة أنَّ هذا نوعًا من التفكر الذاتي البنَّاء ويعكس مثالًا يُعتد به؛ لأنَّه عندما يعمل الخبراء مع الأنظمة الاستبدادية، أو في البلدان التي أدي فيها الفساد المستشري إلى اندثار حكم القانون، فهم يوَرِّطون أنفسهم في بيئات محفوفة بالمخاطر.
وأشارت إلى أنه من حيث المبدأ، يسعى الخبراء إلى ترشيد عملية صنع القرار الحكومي، وتعزيز الشرعية، وتشير الأدلة إلى أنَّهم غالبًا ما يحققون هذه الأهداف في بيئات سياسية منفتحة، لكنها تتساءلت عن مدى نجاح الخبراء في تحقيق تلك الأهداف في أي من الظروف الاستبدادية، وهل ينبغي أن يحاولوا من الأساس؟
وفي سعيها لتسليط الضوء على مثل هذه الأسئلة، أمضت كالفيرت 19 شهرًا بين عامي 2009 و2017 في إجراء بحوث ميدانية في الشرق الأوسط حسب قولها، بالتركيز على الإمارات وغيرها من دول الخليج حيث يعمل الخبراء الأجانب عن قرب مع الحكام في جميع جوانب الحكم تقريبًا. قابلت كالفريت العشرات من الاستشاريين من كبرى الشركات الاستشارية والجامعات، وأشخاصًا من النخب الحاكمة (بما في ذلك أحد الملوك الحكام).

وخلال حضورها اجتماعات في القصر لاحظت كيف يتصرف الخبراء في تفاعلاتهم مع النخب الحاكمة الاستبدادية، موضحة أنهم كثير منهم، بغض النظر عن الصور النمطية الغربية، يهتمون برفاهية مواطني الدول التي تحكمها تلك النخبة لأسباب ليس أقلها الحفاظ على الذات.
وجمعت كالفيرت أيضًا بيانات نوعية وتجريبية حول نظرة المواطنين في هذه البلدان للخبراء والإصلاحات التي يشاركون فيها، ووجدت أنَّ الخبراء الاستشاريين يساعدون الأنظمة في بعض الأحيان على الحكم بشكل أفضل، لكن كفاءتهم، ونطاق تأثيرها يتضاءلان مع مرور الوقت، خاصة عندما يصبحون أقل استعدادًا للتحدث بصراحة عن الأسباب التي تعرقل التقدم. والأكثر وطأة من ذلك، بحسب الكاتبة، هو أن العمل مع الخبراء الاستشاريين عمومًا لا يعزز شرعية النظام الاستبدادي، بل قد يؤدي في الواقع إلى العكس كليًا.
وتقول كاتبة المقال: «إن هذه النتائج مهمة لمناقشات السياسة الخارجية في واشنطن وعواصم غربية أخرى، حيث يناضل صانعو السياسة في تحديد استجابتهم لموجة الحكم الاستبدادي الصاعدة حول العالم. قد يجادل المرء بأنَّ المساعدة التي يتلقاها المستبدون في أماكن مثل الصين والسعودية من الخبراء الغربيين تتعارض مع المصالح الأمريكية، خاصة عندما تسهم تلك المساعدة في قمع الأنظمة الاستبدادية للمعارضة وانتهاك حقوق الإنسان».
لكن الكاتبة تقول: «إنَّ هذه الأنظمة ظلت ثابتة بشكل ملحوظ، على الرغم من التنبؤات بانهيارها الوشيك لعدة أسباب، بما في ذلك ثرواتها الطبيعية، والنمو الاقتصادي الناتج عن العولمة، معتبرة أن المساعدة التي يقدمها هؤلاء الخبراء ليس لها أهمية أكبر مقارنة بتلك العوامل، وتوقعت أنه في حال انسحاب الخبراء الغربيين من الصين والسعودية، فلن تنهار تلك الأنظمة فجأة».
وبحسب الكاتبة، فحقيقة أنَّ الخبراء لا يساعدون في دعم الأنظمة الاستبدادية بقدر ما قد يعتقد النقاد لا تعني أنَّ عملهم ليس له آثار استراتيجية، رغم أن هذه الآثار قد تكون غير بديهية، وحتى مثيرة للسخرية. وترى كالفيرت، بحسب ما توصلت إليه في بحثها، أنه في حال استطاع الخبراء الدوليون تقويض شرعية الأنظمة الاستبدادية عن غير قصد، فقد ينتهي بهم الحال إلى الإسهام في إحداث تطورات إيجابية قد يشجعها حتى أشد منتقديهم قسوة.
قول الحقيقة لمن هم في السلطة لبعض الوقت
قد يتوقع المرء من الخبراء الذين يُقدِّمون المشورة للأنظمة الاستبدادية أن يكونوا رجالًا خاضعين، وأن يخبروا عملائهم بكل ما يرغبون في سماعه، إلا أنَّ الحقيقة أكثر تعقيدًا، بحسب ما جاء مقال كالفيرت، الذي أشار إلى أن بعض الخبراء لا يحترمون المبادئ مثل الآخرين.
ففي منطقة الخليج الغنية بالموارد، العديد من المستشاريين مسوَّقون عدوانيين، يروجون لحلول تناسب الجميع في ما وصفه أحد من قابلتهم كالفيرت بأنَّه «حالة هياج شديد» من الخبراء الذين يتنافسون على العقود، بينما يتخصص آخرون في المجالات «الأقل شهية» في الأنظمة الاستبدادية، مثل مجالات الأمن والمراقبة، وهو الاتجاه الذي أثار على الفور رد فعل عنيف داخل البلدان التي يقدمون لها المشورة، وعلى المستوى الدولي بحسب المقال.
رغم ذلك، يبدو أنَّ معظم الخبراء، بحسب كالفيرت، مهتمون حقًا بإحداث فرق إيجابي في مجالات مثل التعليم والبنية التحتية والإدارة الاقتصادية، ولا يشعرون بأنَّهم متورطون بشكل خاص في الانتهاكات الاستبدادية، بل في الواقع يرون أنفسهم يساعدون في إحداث التغيير النافع من الداخل.
وتضيف الكاتبة أنهم غالبًا ما يفعلون ذلك، على الأقل في البداية، عند دراستهم لتحديات السياسات، وجمع المعلومات، والوقوف على الحلول المحتملة. ففي هذه المرحلة المبكرة، يكون الخبراء في وضع جيد لممارسة تأثير عقلاني على النخب الحاكمة الاستبدادية، التي قد تكون غير مدركة للمشاكل على نحو مدهش، بعد أن عزلهم مساعدوهم عن الواقع.
وتضرب مثلًا على ذلك بقطاع التعليم؛ إذ يجمع الخبراء بيانات قيّمة، بما في ذلك البيانات على المستوى المحلي، ويشاركون تقاريرهم الصريحة المذهلة مع النخب الحاكمة. في الواقع، مشيرة إلى أن أحد المستشاريين الذي يتمتع بالعديد من سنوات الخبرة في العمل في البحرين وصف تقريرًا سابقًا لشركة ماكنزي عن النظام التعليمي هناك بأنَّه «متعمق للغاية، وكشف أشياءً كانت محرجة للغاية للنظام».
وتقول كالفيرت: «إنَّ الخبراء مستعدون عمومًا لتوضيح الحقيقة للسلطة في هذه المرحلة المبكرة، لكن المشاكل تتطور مع تقدم عملية صنع القرار، ويُطلب من الخبراء تقييم مسارات العمل المختلفة المحتملة. بمرور الوقت، يتعلم الخبراء، ثم يتكيفون مع الحوافز المتجذرة في السياق السياسي الاستبدادي، لتغيير نصائحهم أو الحد منها».
وبحسب الكاتبة فالمستشارون يتعلمون مع الوقت عدة أمور، أولها أنه يمكن الاستغناء عنهم بسهولة، مع وجود فرصة ضئيلة للغاية للانتصاف لهم أو تعويضهم، على الرغم من التأكيدات الأولية بعكس ذلك، إضافة إلى ذلك يمكن ترحيل الخبراء الأجانب بسرعة، أو يُطلب منهم المغادرة بكل أدب، ويمكن تخفيض درجة أو رتبة الخبراء المحليين دون تقديم أي تفسير تقريبًا.
ثانيًا يبدأ الخبراء في إدراك جو التنافس الشديد الذي يعملون فيه بشكل أكثر وضوحًا، ويُجَرّون إلى أجواء الدسائس التي تُحاك في القصر، التي وصفها أحد المستشاريين ـ الذي يتخذ من البحرين مقرًا له ـ بأنَّها لعبة كراسي موسيقية: «أولًا، رئيس الوزراء، ثم ولي العهد، ثم وزير التعليم»، كلهم يتنافسون في قطاع الإصلاح التعليمي، وكلٌ منهم لديه فريق من الخبراء خاص به.
أخيرًا يجد الخبراء أنفسهم هم كبش الفداء المناسب عندما تتعثر هذه الإصلاحات. في قطر، على سبيل المثال، أكد خبير رفيع المستوى في قطاع التعليم يعمل لدى مؤسسة راند البحثية لكالفيرت أنَّه «بمجرد أن تسوء الأمور، فإنَّ ما كنا نفعله يُرفض (..) على الرغم من أنَّه كان من الواضح أنَّ الأمير هو الذي اختار ذلك».
وتشير كالفيرت إلى أنَّه بمرور الوقت، يصبح الخبراء أقل استعدادًا لنقل الحقيقة إلى السلطة، أو على الأقل بصراحة، لافتة إلى أنَّ جو عدم اليقين وانعدام الأمن الذي اعتادوه يؤدي بهم في النهاية إلى القلق أكثر بشأن وضعهم. ونقلت عن كثيرين قولهم: «إنَّ استراتيجية البقاء الذكية لا تكمن في الكذب، ولكن في نقل قدر قليل جدًا من الحقيقة».
وقال مطور الأعمال السعودي للكاتبة: «يقول (الخبراء) آراءهم في اليوم الأول، ثم يُقال لهم: «لا، نريد أن نفعل ذلك بهذه الطريقة»، وبعد ذلك سوف يصمتون ويفعلون ما يُقال لهم. هم يعلمون أنَّ شخصًا آخر سيأتي ويأخذ مكانهم إن لم يفعلوا ذلك».
وتكون نتيجة ذلك، بحسب كالفيرت، هي أنَّ جودة المشورة التي يقدمها الخبراء غالبًا ما تتدنى، وفي مرحلة ما قد يبدأون في جعل الأمور أسوأ. وتقول إنَّه مع وجود كبار الخبراء إلى جانبهم، أصبحت النخب الحاكمة تشعر بالثقة المفرطة، خاصة في ما يتعلق بقدرتهم على تتبع التغييرات التي يريدونها بأقل تكلفة ممكنة، مضيفة أنهم يتبنون أقصر الطرق لبناء الدولة، ويجد المستشارون أنفسهم يساومون على الأطر الزمنية.
وأوضح أحد كبار مستشاري التعليم في الإمارات لكالفيرت الأمر قائلًا: «كانت الخطة التي وضعتها تتمثل في إصلاح جميع المدارس خلال سبع سنوات. لكن بحلول الوقت الذي عدت فيه من إحدى عطلاتي، خفَّضها (وزير التعليم) إلى خمس سنوات، وفي اليوم الثاني، خفض الشيخ محمد بن راشد فترة الإصلاحات إلى ثلاث سنوات». في النهاية، وافق مستشار التعليم على الجدول الزمني المنَّقح، على الرغم من الشكوك حول جدوى الفترة الزمنية. ونقلت كالفيرت عن مطور الأعمال السعودي وصفه للنمط العام على النحو التالي:
«تحاول (النخب الحاكمة) إيجاد حلول إعجازية. يجلسون هناك ويقولون بالأساس: «كيف يمكننا تقليل استهلاك (الطاقة) دون رفع الأسعار (التي قد تنطوي على ثمن سياسي)؟» وسوف تقولون مرة أخرى: «لا يمكننا تحقيق ذلك»، ثم يقولون: «حسنًا، ما هو الحل الذي رأيته يُطبق في بلدان أخرى؟» وتقول لهم «رفع الأسعار»، ثم يقولون: «لا يمكننا رفع الأسعار». وبعد ذلك يمكن أن تستمر هذه المحادثة لمدة ساعة، ثم يأتي صاحب السمو أو غيره ليقول: «عليك أن تجد لي حلًا. أنت خبير استشاري، لقد فعلت هذا من قبل».
تؤكد كالفيرت على تكرار هذه الأنماط ذاتها في نهاية المطاف. وعندما تشعر النخب الحاكمة بخيبة أمل بسبب غياب التقدم، غالبًا ما يلقون باللوم على الخبراء المعنيين، ومن ثم يعينون فريقًا جديدًا من الخبراء، أو ينتقلون إلى مشروعات أخرى حيث تتبنى النخب الحاكمة الأخرى الجهود لمعالجة مشكلات الإصلاح نفسها، وغالبًا ما يصلون إلى النتائج المخيبة للآمال نفسها، ولا يستفيدون من الدروس التي مروا بها في الماضي بسبب ضعف عمليات المراجعة المؤسسية، ونقص التواصل عبر جهود الإصلاح، بحسب المقال.
شرير تعرفه خيرًا من آخر تجهله
على الرغم من هذه النكسات الشائعة، ترى كالفيرت أنَّ الحكام الاستبداديين لا يزالون ينظرون إلى الخبراء على أنَّهم ضروريون لتقديم فكر جديد بشأن الإصلاحات وبناء الدعم الذي يرغبون فيه؛ إذ يرى كثيرون أنَّ البيروقراطيين في دولهم يتبنون وجهات نظر عفا عليها الزمن ومسيَّسة بشكل مفرط، وهو ما قد يكون صحيحًا، على الرغم من أنَّ هذا الأمر يرجع لأنَّ النخب الحاكمة غالبًا ما توزع الوظائف الحكومية المرموقة على الموالين للنظام دون إيلاء اعتبار كبير لعنصر الجدارة.
وتقول الكاتبة: «إن العديد من النخب الاستبدادية تدرك أنَّ استقدام خبراء من الخارج يمكن أن يزعج كثيرين على المدى القصير، لكنهم يميلون إلى الاعتقاد بأنَّ وجود الخبراء يوضح للناس مدى جدية المشكلات التي يواجهونها». إذ أوضح أحد الملوك الحكام في دولة الإمارات للكاتبة، أنه يجب على حكام الخليج أن يثبتوا أنَّهم «ليسوا مثل حسني مبارك»، الرئيس المصري السابق الذي رأى مصريون كثيرون أنه لا يستجيب لاحتياجاتهم، وأُطيح به في ثورة يناير (كانون الثاني) 2011.
ومع ذلك تقول الكاتبة: «إنه ليس من الواضح كيف يؤثر الخبراء على الدعم الشعبي في الأنظمة الاستبدادية. ولجمع أدلة أكثر منهجية على ذلك، أجرت الكاتبة ثلاث تجارب في الكويت لاختبار آثار مشاركة الخبراء، والظروف التي قد يزيد أو يقلل فيها الخبراء من تشجيع المشاركة الشعبية في مشاريع الإصلاح والتنمية».
في التجربة الأولى طُلب من 281 كويتيًا أن يتخيلوا أنَّ قادة بلادهم بدأوا إصلاحًا رئيسًا لتحسين التعليم أو البنية التحتية (عن طريق التكليف العشوائي). قرأوا مقالًا في جريدة وهمية يوضح الإصلاح والفوائد المحتملة القادمة، مثل الحد من الازدحام المروري الذي تشتد الحاجة إليه.
وُزِّع الأشخاص موضع البحث أيضًا عشوائيًا بين حالة «وجود خبراء» وحالة «عدم وجود خبراء». لذلك قرأ نصفهم تقريبًا أنَّ فريقًا من كبار الخبراء الدوليين سيساعد في عملية الإصلاح، ووصِفَّت الشهادات التي يحملها الخبراء وخبراتهم الواسعة في دول أخرى، أما بالنسبة لبقية الأشخاص، لم يُذكر أن الخبراء يؤدون أي دور في جهود الإصلاح.
تؤكد كالفيرت أنَّ النتائج كانت كاشفة، فبعيدًا عن إضفائهم للشرعية، ارتبطت مشاركة الخبراء بانخفاض كبير في الشرعية. فالأشخاص الذين قرأوا الخبر الذي يشير إلى مشاركة الخبراء كانوا أقل ميلًا لدعم ذلك الإصلاح، مقارنة بحالة «عدم وجود خبراء». وكان تأثير نزع الشرعية الذي تسبب فيه وجود الخبراء واضحًا أيضًا بغض النظر عن نوع الإصلاح.
قد يتوقع المرء أنَّ مشاركة الخبراء في مجالات الحكم التي تحتاج لتقنيات أكثر، مثل البنية التحتية، قد تبني ثقة عامة أكبر، لكنَّ النتائج لم تدعم تلك الفرضية أيضًا، بحسب كالفيرت. وعلاوة على ذلك، أظهر أيضًا الأشخاص الذين تفاعلوا سلبًا مع الإصلاح الذي قاده الخبراء شعورًا عامًا بعدم الارتياح تجاه بلدهم في شكل تقلص روح الوطنية.
أما التجربة الثانية فقد اختبرت ما إذا كانت جنسية الخبراء مهمة لمسألة الشرعية. وجه الأشخاص موضع البحث عشوائيًا لقراءة قصص إخبارية حول إصلاحات البنية التحتية التي ينصح بها الخبراء؛ كانت الأخبار التي قرأتها كل مجموعة متطابقة فيما عدا أنَّ الخبراء وصفوا بأنَّهم أمريكيون أو صينيون أو كويتيون.
ومن المثير للدهشة، بحسب الكاتبة، أنَّه عندما قيل إنَّ الخبراء الذين سيشاركون في عملية الإصلاح أمريكيون، أعرب المبحوثون عن دعمهم للإصلاح بشكل أقل مقارنةً بما حدث عندما ذُكِر أنَّ الخبراء من الجنسيتين الأخيرتين، وكان هذا في الكويت، البلد التي غالبًا ما يُنظر إلى سكانها على أنَّهم أكثر تأييدًا لأمريكا من جيرانهم الخليجيين؛ بسبب دور الولايات المتحدة في الرد على غزو العراق للبلاد في عام 1990.
ومع ذلك، لم يختلف دعم الإصلاح اختلافًا كبيرًا، سواء كان هناك خبراء صينيون أو كويتيون، وقد أوضح الأشخاص موضع البحث أنَّهم رأوا الخبراء الصينيين أكثر قدرة من الأمريكيين والكويتيين. وعلى الرغم من أنَّ هذه النتيجة قد تكون مخيبة للآمال بالنسبة للاستشاريين الأمريكيين، تقول كالفيرت: «إنَّها ليست بالضرورة دليلًا على معاداة قوية لأمريكا، ناهيك عن الحب الجديد للخبراء الصينيين، بل إنها على الأرجح تعكس تجربة الكويتيين الطويلة مع الخبراء الأمريكيين (والبريطانيين)، بما في ذلك إحباطهم من عدم إحراز تقدم في مختلف الإصلاحات».
وألمحت الكاتبة إلى أنَّه قد يكون الخبراء الصينيون، الذين لا يعرف عنهم المواطنون الكويتيون كثيرًا في هذه المرحلة، مجرد «الشرير الذي لا يعرفونه».
وأشارت كاتبة المقال إلى أنَّ التجربة الثالثة تباينت في طول المدة التي قيل للأشخاص موضع البحث «إنَّ الخبراء قضوها في البلد». إذ قرأت إحدى المجموعات في المقال أنَّ الخبراء الدوليين «وصلوا بالأمس»، فيما المقال الآخر يشير إلى إنَّهم «يعيشون ويعملون في الكويت منذ 10 سنوات».
وبخلاف هذا الاختلاف، كانت القصص الإخبارية متطابقة. وأشارت كالفيرت إلى أنَّ النتائج كانت واضحة: ارتبط الخبراء الذين قضوا مدة أطول بشرعية أكبر بكثير من أولئك الذين قضوا مدة قصيرة. كان الأشخاص موضع البحث أكثر دعمًا للإصلاح، وأكثر ثقة في نجاح عملية الإصلاح، وأكثر ثقة بشأن الخبراء أنفسهم عندما قيل إنَّهم كانوا في البلاد منذ فترة طويلة.
وبحسب مقال كالفيرت فهذا الأمر يثير معضلة، لأنَّه كلما ظل الخبراء في المشهد، زاد احتمال انجذابهم إلى هياكل الحوافز الاستبدادية التي تقوض قدرتهم على المساعدة في تحسين الحكم. لذا فإن أولئك الذين يمتلكون معظم المعرفة المحلية بعد قضاء سنوات في البلد، والذين قد يكونون أكثر ملاءمة لتقديم المشورة للحكام هم أنفسهم قد يكونون الأقل فاعلية. فقد تأتي عقلنة السياسة على حساب الشرعية، والعكس صحيح.
إذ كنت من هؤلاء الخبراء فانصح نفسك
تقول كاتبة المقال كالفيرت: «إنَّ هذه الأدلة التجريبية تثير شكوكًا حول قدرة الخبراء على ترشيد الحكم الاستبدادي وإضفاء الشرعية عليه، ولا يعني أنَّ هؤلاء الخبراء لم يكن لهم أي آثار إيجابية في مثل هذه السياقات، لكن التحديات أكثر أهمية مما قد يدركه كثيرون، خاصة بالنسبة للمستشاريين الذين يعملون مباشرة مع النخب الحاكمة في مستويات رفيعة في الحكومات».
ترى كالفيرت أنَّ جزءًا من المشكلة هو الاستبداد نفسه، وليس هناك كثير مما يمكن فعله حيال ذلك طالما لن يتغير النظام. ولكنَّها أوردت بعض الطرق التي قد يتجنب بها الخبراء المخاطر: تركيز جهودهم على مرحلة تقصي الحقائق لحل المشكلات على سبيل المثال، وإظهار استعداد أكبر للرحيل إذا تجاهل القادة الحلول المقترحة.
ولإعادة بناء ثقة الناس والشرعية، تنصح كالفيرت الخبراء بقضاء وقت إضافي في البلد للتعرف على السياق المحلي، وإن كان عليهم توخي حذر الانزلاق وراء الحوافز ذات الأثر العكسي كلما بقوا لفترة أطول.
وحتى لو استطاع الخبراء الاستشاريون أن يفعلوا ما هو أفضل، تقول الكاتبة: «إن البعض قد يرى أنَّه ينبغي عليهم ببساطة تجنب العمل مع الأنظمة غير الديمقراطية، وخاصة تلك المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنَّ نظام العقوبات يحظر بالفعل مثل هذا التعاون في بعض الحالات».
ومع ذلك، نادرًا ما تكون الأنظمة جيدة أو سيئة كليًا، والخبرات قد تكون مفيدة بشكل خاص في السياقات السياسية المنغلقة، بما في ذلك المساعدة في تجنب العواقب الوخيمة المحتملة للسياسات السيئة من قبيل حوادث النقل الجماعي، والمجاعات، والتدهور البيئي، وما إلى ذلك.
علاوة على ذلك، فإنَّ الخبراء الاستشاريين ربما لا يدعمون الأنظمة الاستبدادية مثلما يعتقد بعض منتقديهم، في الواقع، يشير بحث كالفيرت إلى أنَّ الخبراء الدوليين يمكنهم بالفعل تقويض شرعية الأنظمة؛ مما قد يقلل الدعم المحلي للحكام المستبدين ويضعف أنظمتهم.
وبالتالي فإنَّ أخلاقيات عمل الخبراء مع مثل هذه الأنظمة معقدة، فهي تشبه ما يصفه منظّرو الأمن القومي بـ«معضلة الاستخدام المزدوج»، والتي تنشأ عندما يمكن استخدام شيء ما لمنفعة الإنسانية ولكنَّه يلحق الأذى أيضًا، بحسب كالفيرت، التي أشارت إلى أن الحكام قد يستخدمون مشورة الخبراء لتحسين حياة الناس، لكنَّهم قد يستخدمونها أيضًا في قمع المعارضة وتقييد الحرية الفردية وارتكاب انتهاكات أكبر ضد حقوق الإنسان.
وتقول الكاتبة: «إنَّ الخبراء قد لا يدركون هذه المخاطر دائمًا»، وضربت مثالًا على ذلك بالبيان العلني الذي أصدرته شركة ماكنزي في أواخر العام الماضي ردًا على التغطية الصحافية المنتقدة لها بسبب عملها مع الأنظمة القمعية والفاسدة، والتي نشرتها صحيفة «ذا نيويورك تايمز» الأمريكية. استشهدت ماكنزي بالتغيير الإيجابي الذي ساعدت على إحداثه في جميع أنحاء العالم وقالت: إنَّها «مثل العديد من الشركات الكبرى الأخرى، بما في ذلك منافسينا، نسعى إلى العمل في بيئة جيوسياسية متغيرة، لكنَّنا لا ندعم الأنشطة السياسية أو نشارك فيها».
المشكلة، بحسب كاتبة المقال، هي أنَّ المساعدة الفنية التي يقدمها الخبراء قد تكون في النهاية سياسية للغاية حتى لو لم تكن مقصودة على هذا النحو، مضيفة أنَّه من الصعب للغاية، على أرض الواقع، منع المساعدة والمشورة التي يقدمها أي شخص للحكومة من التأثير على «الأنشطة السياسية»، إذ إنَّ كل ما تفعله الحكومة هو في الأساس نشاط سياسي.
وتضيف كالفيرت أنَّه قد يكون من المفيد التفكير في هذه المخاطر على أنَّها موجودة على مسار متصل، على أحد جانبيه، هناك المخاطر العالية التي تأتي من تقديم المشورة للحكام المستبدين بشأن القطاعات المرتبطة ارتباطًا وثيقًًا بالقوة القسرية للأنظمة الاستبدادية، مثل الأمن الداخلي والمراقبة.
وعلى الجانب الآخر، هناك مخاطر أقل مرتبطة بتقديم المشورة في قطاعات مثل التعليم وجمع القمامة وسلامة الطرق. وترى الكاتبة أنَّه قد يكون الخبراء في وضع أفضل إذا ركزوا على الجانب الأخير، رغم أنَّه من المهم إدراك أنَّه حتى هذه القطاعات ليست محصَّنة ضد المعضلات الأخلاقية.
على سبيل المثال، قد يعمل المستشاريون مع وزارات التعليم لتحسين كيفية تعلم الطلاب في المدارس العامة للمهارات المطلوبة في سوق العمل، ليجدوا أنَّ النخب الاستبدادية تستخدم أيضًا المدارس لتلقين الطلاب عقائديًا.
لكي ينجح الخبراء في عملهم في ظل هذه الأجواء الصعبة، ترى كالفيرت أنَّهم بحاجة إلى تطوير مبادئ توجيهية ترشدهم إلى الأمور التي يُفضَّل أن يتعاونوا فيها مع هذه الحكومات، وإلى الأمور التي لا يُستحسن أن يتعاونوا فيها معهم.
واستشهدت بوصية مايكل بوسنر، مدير مركز الأعمال وحقوق الإنسان في كلية ستيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك، بأنَّ يضع المستشاريون مبادئ توجيهية واضحة بشأن متى يرفضون العمل مع أي حكومة، وكيفية الرد عندما يطلب منهم عميل حكومي المساعدة بشأن مسألة ننتهك الحقوق الأساسية، ومتى ينسحبون من العقود الحكومية القائمة، ولكنَّها غير ملائمة. وتضيف كالفيرت أنَّ كل هذه الأمور محورية لتحقيق التوازن، لكنَّ معضلة الاستخدام المزدوج تضفي مزيدًا من التعقيد، ففي السياقات السياسية الغامضة، يصعب على الخبراء معرفة في ماذا سوف تُستخدام خبراتهم في نهاية المطاف.
تُقِّر كاتبة المقال بأنَّه ليس من السهل حل هذه المشكلة الأعمق، لكن الأبحاث حول معضلات الاستخدام المزدوج في مجالات أخرى تشير إلى أنَّ الشفافية ومشاركة المعلومات يمكن أن تساعد في هذه الحالة. إذ يجب على مجتمع الخبراء أن يدفع بقوة نحو هذين الاتجاهين عندما يتعلق الأمر بعملهم في إطار نظم استبدادية.
وعلى الرغم من أنَّ التنافس بين بعضهم البعض يمكن أن يكون عائقًا، تقول الكاتبة: «إن الخبراء يحتاجون إلى تبادل خبراتهم فيما بينهم بشكل روتيني، بهدف بناء قاعدة معرفية أقوى فيما يتعلق بالعملاء الحكوميين، وقطاعات بعينها، فضلًا عن أن يتشاركوا سويًا خبراتهم بخصوص مصير المساعدة الفنية التي قدموها في كل حالة على حدة».
وتضيف أنَّه على الرغم من أنَّ الأنظمة الاستبدادية نفسها غير معروفة بشفافيتها، فإنَّ المؤسسات في الديمقراطيات الليبرالية التي يوجد بها العديد من الخبراء الدوليين – الشركات الاستشارية، ووكالات المعونة الحكومية، والجامعات، والمنظمات غير الحكومية مثل مراكز الفكر – يمكن أن تكون أكثر شفافية بشأن ما تفعله في مثل هذه السياقات السياسية والنتائج التي يحققونها.
وتشير إلى أنَّ الباحثين لديهم أدوات لقياس فعالية العديد من أنواع التدخلات في إدارة الحكم والمجتمع، ولكي يستخدموها، يجب أن يكون لديهم صورة أوضح عما يفعله الخبراء، ولفتت إلى أنه لا يكفي أن تجري المنظمات مثل هذه الأبحاث على نفسها، بطبيعة الحال نظرًا لإشكالية تضارب المصالح.
وفي نهاية مقالها، توضح كالفيرت أنَّ استعانة الزعماء بالخبراء الخارجيين ليست ظاهرة جديدة، لكنَّ انخراط الخبراء في الأنظمة الاستبدادية يتزايد بصورة كبيرة، وكذلك المجالات التي يُطلب منهم تقديم المشورة بشأنها.

ولذلك تنصح كالفيرت المنظمات التي تقدم الخدمات الاستشارية بأن تُفصح أكثر عن طبيعة العملاء الذين تتعامل معهم، وطبيعة العمل عملهم، والنتائج التي يحققونها، وكذلك العقبات التي يواجهونها؛ لأنَّهم إذا فعلوا ذلك يمكنهم الاستمرار في تطبيق خبراتهم، وتحقيق الربح في الوقت الذي يُحسِّنون فيه إمكاناتهم لإحداث تغيير إيجابي للأفراد الذين يعيشون في كنف هذه الأنظمة.