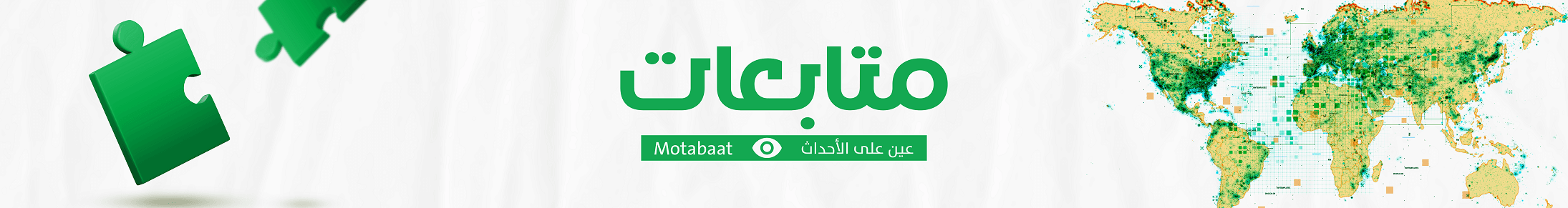جريمة في حق الحضارة الانسانية.. الإبادة المكانية وسياسة قتل المدن
متابعات..| تقرير*
تاريخياً عمدت القوى الاستعمارية وبشكل هستيري إلى تدمير المدن تحت عنوان السيطرة على الارض يعني هزيمة العدو واستسلامه، بقيت هذه الاستراتيجية حاكمة لكل الحروب العالمية، وفي كل مرة كانت القوى المسلحة بعظمة ما تمتلك من مقومات التدمير توغل في ضرب كل منابع الحياة، فتقصف المدن وتدمر المنشآت المدنية والحضارية والتاريخية، لتبني محلها استعماراً بألوان مختلفة.
هذه القوى الاستعمارية ذاتها، وبعد سنين من التدمير والابادة، بادرت لانشاء قواعد تحد من هذه السياسة بل تقنّنها بعنوان حماية المدنيين، وتحديد آليات القتال، والضرورة العسكرية.
يحدد القانون الدولي الانساني الذي أنشأه الغرب بعنوان قواعد حماية في زمن الحرب والنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، أحكامًا للحماية العامة للممتلكات والأشياء المدنية. إذ يحظر الهجمات، والأعمال الانتقامية أو أعمال العنف الأخرى ضدّ مثل هذه الممتلكات في النزاعات الداخلية والدولية. ويحدد ذات القانون، تعريفا للمنشآت المدنية، على أنها جميع الأشياء التي لا تشكل أهدافًا عسكرية. وتنحصر الأهداف العسكرية في الأهداف التي تشكل بطبيعتها وموقعها وغرضها أو استعمالها مساهمة فعَّالة في العمل العسكري والتي يوفِّر تدميرها الكامل أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها ميزة عسكرية محدّدة. وفي حال وجود شك بشأن شيء ما يستعمل عادة لأغراض مدنية، مثل مكان عبادة، أو بيت أو مكان سكن آخر، أو مدرسة، يجب على أطراف نزاع ما أن تفترض أن هذا الشيء لا يستعمل لأغراض عسكرية (البروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 المادة 52). وتنص القاعدة التاسعة من دراسة القانون الإنساني العرفي أن “الأعيان المدنية هي جميع الأعيان التي ليست أهدافًا عسكرية”. وتنص القاعدة العاشرة على أنه “تُحمى الأعيان المدنية من الهجوم ما لم تكن أهدافًا عسكرية وطوال الوقت الذي تكون فيه كذلك”. وتنطبق هاتان القاعدتان على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
ويحظر القانون الإنساني استعمال العنف، والهجمات التي توجّه ضدّ الأهداف العسكرية والأشياء المدنية دون تمييز، مثل تلك التي تهدف أساسًا إلى بثّ الذعر بين السكان المدنيين (البروتوكول 1 المادة 51). ويحدّد القانون الإنساني احتياطات محدّدة يجب اتّخاذها للحدّ من آثار الهجمات على السكان المدنيين والأشياء المدنية (البروتوكول 1 المادتان 57 و58). وعلى القادة العسكريين التزام بضمان تنفيذ هذه الإجراءات. وتنص القاعدة السابعة على أن أطراف النزاع يجب عليها في كل الأوقات التمييز بين الأشياء المدنية (التي تخضع للحماية) والأشياء العسكرية. وهي تُذكِّر أيضًا بأن الهجمات لا يجوز أن تكون موجهة إلى أهداف عسكرية، ويجب ألا توجَّه إلى أهداف مدنية. وتنطبق هذه القاعدة من القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
كل هذه القواعد المذكور شكّلت أساسا للحماية الدولية، لكن مع ذلك، لا تشير هذه الاتفاقيات والقواعد الانسانية إلى تدمير المدن وابادتها كجريمة وانتهاك، ربما ليس سهوا ولكن حرصا على تحديد الاهداف العسكرية وغير العسكرية المحكومة بهذه القواعد.
من هذا المنطلق من الضروري تحديد:
1- إبادة المدن هدف سياسي وعسكري للعدو
2-تاثير ابادة المدن على البنية الاستراتيجية للبيئة المستهدفة وخياراتها في مواجهة العدو.
1)ابادة المدن هدف عسكري وسياسي للعدو
مع تطور الثورة الصناعية أصبحت المدينة تعبّر عن ثقل اقتصادي ومركز سياسي، وصار استهدافها ليس غاية عسكرية للقضاء على الجيوش، إنما للتأثير على صناعة القرار السياسي الذي يقيس مدى قدرة المدينة -وبالتالي النظام الحاكم- على الصمود. ظهرت في القرن التاسع عشر أيضًا الدول القومية التي تتحمل مسؤولية الدفاع عن مُدنها وما تمثله من مراكز حضارية بتفاعلاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بعكس الإمبراطوريات متعددة التمركز أو دول المدن (city states) التي يُقضى عليها بمجرد القضاء على المدينة. في الحرب العالمية الأولى، بدأ قصف المدن الكبرى كهدف سياسي مقصود رغم أن معظم المواجهات كانت في المساحات المفتوحة، وساعد تطور السلاح على استهداف المدن دون الحاجة إلى جيوش لاجتياحها بريًا، إنما عبر القصف الجوي، وهو ما قامت به إيطاليا لأول مرة عند استهداف العاصمة الليبية طرابلس عام 1911.
إنّ «قتل المدن هو أقدم قصة في العالم»، يقول الكاتب الماركسي الأمريكي مارشال بيرمان، في إشارة إلى أن الإبادة المكانية كممارسة أقدم بكثير من المصطلح الذي ظهر في الستينيات ما بين 1963-1968 لوصف ممارسات التجديد الحضري العنيفة في الولايات المتحدة، مثل هدم مناطق واسعة لإعادة بنائها بهوية مختلفة.
بعد حصار سراييفو الذي امتد لثلاث سنوات وعشرة أشهر (نيسان 1992 – شباط 1996) خلال حرب البوسنة، أصبح المصطلح يستخدم بشكل متزايد من قبل المهندسين المعماريين والمخططين الحضريين والمؤرخين لوصف العنف العسكري الموجه لتدمير نسيج منطقة حضرية، خصوصًا وأن تعريف الإبادة الجماعية على أنها «خطة مُحكمة من الإجراءات المقصودة التي تهدف لتدمير أسس المجموعات الوطنية»لم يتطرق للعنف الذي لا يستهدف الأجساد البشرية.
تعني الابادة المكانية تخفيض رتبة المدينة إلى أقل من كونها مدينة، عبر ممارسة العنف على كل مقوماتها الحيوية بما فيها منظومتها المعمارية والبنيوية والتحتية والاجتماعية، ونظامها الاقتصادي، وتنوعها الثقافي، وحتى الحالة الذهنية التي يتشاركها سكان المدينة حولها. ويمكن القول إنّ«الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي» والإبادة المكانية متلازمان في الغالب، ويجادل البعض بأن قتل المدن هو جزء من الإبادة الجماعية، لأن تدمير منازل الناس يعني تدميرهم، لكن وجود مفهوم الإبادة المكانية يساعدنا على تفادي النظرة السطحية للدمار المعماري كضرر جانبي للحروب بل كهدف سياسي يكون متعمدًا دوما دون أي ضرورة عسكرية أو أمنية، وهو بذلك يضيف انتهاكا جديدا لكل القوانين والمواثيق الدولية والانسانية. في ختام الحروب اليوغوسلافية، ظهر المصطلح كمفهوم قانوني في القانون الدولي، لكن تعريفه ومؤشراته ما زالت غير دقيقة وموضع نقاش.
يشير تعبير إبادة المدن إلى نمط التدمير المتعمّد لعناصر البنى التحتية المتكاملة، بوصفه شكلًا من أشكال العنف السياسيّ في حدّ ذاته. وقد نشأ مفهوم إبادة المدن تراكميًّا خلال مناقشات متعدّدة حول برامج التجديد الحضريّ في الولايات المتّحدة الأمريكيّة، وكان المقصود منه الإشارة إلى الطريقة الّتي تعرّضت بها المدينة، سواء كشكل معماريّ أو تجربة اجتماعيّة وسياسيّة، للهجوم في التخطيط والتطوير الحضريّ في القرن العشرين. استخدمت المصطلح الناقدة المعماريّة آدا لويز هاكستابل (1921 – 2013)، الحائزة على «جائزة بوليتزر» للعنوان الفرعيّ لمقالاتها في “نيويورك تتايمز” وكذلك المنظّر الأمريكيّ مارشال بيرمان (1940 – 2013)، الّذي تُنْسَب إليه إعادة تشكيل المصطلح مفاهيميًّا، ودراسته في سياق الحداثة وما بعدها. وهنا يمكننا فهم التحوّلات الراديكاليّة في التخطيط الحضريّ في القاهرة مثلًا، باعتبارها فعلًا من أفعال الحروب والإبادة الجماعيّة، باسم التحضّر والتخطيط، فإبادة المدن تخطيطًا شكل من أشكال الخطاب السياسيّ، وبالتالي فإنّ ما حدث في البوسنة لا يختلف في جوهره عمّا حدث في نيويورك من قبل، وعمّا حدث في القاهرة لاحقًا.
وعليه؛ فإنّ إبادة المدن محاولة لترسيم حدود القتل والتدمير، باعتباره ممارسة ممتدّة ومتداخلة من تدمير الإنسان والعمران، بكلّ عناصرهم المتقابلة والمتعاضدة، باعتبارها ظاهرة واحدة، بدلًا من حالات معزولة أو ثانويّة، وأنّها هدف للسياسيّ كما العسكريّ. والسياسيّ في إبادة المدن رديف العسكريّ الحربيّ، فهو فعل إثنوقراطيّ بالأساس، يسلّط الضوء على عنف تمييزيّ مكانيّ من خلال تحليل المنطق السياسيّ في هندسة المكان وإنتاجه.
يشير مصطلح إبادة المدن خطابيًّا إلى كلٍّ من التشابه والتمييز بين العنف الّذي يؤثّر في البيئة المبنيّة والإبادة الجماعيّة. فمن ناحية، في اللغة الإنجليزيّة، يعتمد مصطلح إبادة المدن (Urbicide) على تشابه معجميّ مفاهيميّ مع الإبادة الجماعيّة (Genocide)، من حيث اللاحقة (cide-) من أجل تأكيد حجم التدمير الّذي يحدث وأهمّيّته. بينما من ناحية أخرى، يؤكّد مفهوم إبادة المدن على أنّ تدمير البيئة المبنيّة هو حدث، على الرغم من ارتباطه بالإبادة الجماعيّة، إلّا أنّه مميّز من الناحية المعجميّة، وبالتالي من الناحية المفاهيميّة، وعليه؛ ثمّة ترادف مفاهيميّ بين بنية الجماعة المتخيّلة وبيئتها المبنيّة، وما يستلزمه ذلك من علاقات وبنًى.
وقد تنبّه رافييل ليمكين (1900 – 1950) في بحثه في تاريخ تدمير المدن، إلى الحاجة إلى صكّ كلمة جديدة للعنف الّذي ارتكبه النازيّون. على الرغم من وجود أعمال عنف مختلفة عبر التاريخ يمكن مقارنتها من أجل فهم العنف النازيّ، يستشهد ليمكين، من بين أمور أخرى، بمثال تدمير قرطاج في عام 146 قبل الميلاد. إذ كان من الضروريّ، كما جادل ليمكين، صياغة مصطلح جديد يأخذ في الاعتبار الطابع المنهجيّ للهولوكوست، محاججًا أنّ الإبادة الجماعيّة تعني “خطّة منسّقة لإجراءات مختلفة تهدف إلى تدمير الأسس الأساسيّة للجماعات القوميّة؛ بهدف إبادة المجموعات نفسها”.
لفهم من أين تبدأ العلاقة بين إبادة الانسان في الإبادة الجماعيّة، وإبادة المكان، أو المدينة؛ لعلّنا نتنبّه إلى ما أشار إليه بول كونورتون (1940 – 2019)؛ في محاولة لإجابة السؤال: كيف يغزو النسيان ذاكرة الحداثة؟ إذ يقول: “المنزل والجسد، يجمعهما قاسم مشترك؛ إذ يأخذهما الإنسان مأخذ المسلّمات، حيث نميل إلى أن نأخذ أجسامنا على أنّها من المسلّمات حتّى تخذلنا من خلال حادثة أو من خلال المرض أو الشيخوخة، الأمر نفسه ينطبق على المنزل؛ حيث ننظر إليه على أنّه من المسلّمات إلى أن تحدث ظروف استثنائيّة، مثل الانتقال من المنزل، أو خلاف أسريّ، أو اندلاع حريق أو حرب”. وفي مقالته الكلاسيكيّة «العمران كطريقة للحياة»، يجادل لويس ويرث (1897 – 1952) بأنّ حجم سكّان المدن وكثافتهم وعدم تجانسهم هي العناصر الّتي تشكّل “عناصر التحضّر (Urbanity) الّتي تكرّسها نمطًا مميّزًا للحياة”، على الرغم من تعداده لتلك العناصر الثلاثة، إلّا أنّ عدم التجانس هو العنصر الرئيسيّ.
وعليه، فإنّ إبادة المدن تدمير يتخطّى إبادة الجماعة إلى إبادة امكاناتها واثارها وتاريخها الماضي والحاضر والمستقبل، باختصار هي مسح بمعنى الفناء، وقتل بمعنى الالغاء، وسحق بمعنى الارض المحروقة.
يستلزم مفهوم الإبادة الجماعيّة فهم فعل التدمير – فعلًا ومنهجيّة –بكلمات أخرى؛ إبادة الجسد في الإبادة الجماعيّة ليست محدودة بإفنائه بوصفه كيانًا مادّيًّا فقط، بل كيانًا رمزيًّا ومعنويًّا، وبالتالي؛ فإنّ الهدم هنا بصفته فعل إبادة للمدن ليس إلّا إعادة إنتاج لها في المخيال المشترك؛ أي أنّ دمار مدينة غزّة أو قرى الجنوب اللبناني او البقاع او الضاحية الجنوبية لبيروت، جزء من مقولة إنتاج غزّة حربيًّا، وعليه؛ فإنّ الهدم له معماريّته أيضًا، وهو ما يفسّر كون الخرائب نصًّا معماريًّا، وأداة إنتاج مكانيّة المستعمَر، ولها جانب من السياسات الحيويّة.
إنّ قتل الانسان ليس وسيلة لتحقيق الابادة بل هو متمم لمشروع واهداف يعمل العدو من خلالها لمحو الذاكرة والتاريخ والحضارة الانسانية، والامر ذاته في ابادة المدن، التي هي جزء من الابادة الجماعية بل هي عنوان اساسي لاكثر الجرائم الانسانية بشاعة.
من هنا بالتحديد يمكن ملاحظة التكامل بين إبادة المدن والإبادة الجماعيّة، في رسم تشابه بين تدمير النسيج الحضريّ وتدمير نسيج المجموعات العرقيّة. لوحظ من قبل بعض الباحثين أنّ تدمير النسيج الحضريّ استمدّ معناه من العلاقة بين التدمير وما هو ’هو‘ الّذي يُدَمَّر. يستلزم لإبادة المدن تدمير المباني باعتبارها العناصر المكوّنة للتحضّر والاختلاف والتعدّد، وتدمر المباني لأنّها شرط إمكانيّة التحضّر، ومساحات التفاوض العمرانيّ الجغرافيّ.
ابادة المدن استراتيجية العدو لابادة البشر، وهي خياره للسيطرة والاحتلال، ولا يمكن باي شكل من الاشكال الحديث عن فروق بين الابادتين فابادة الحجر من ابادة الانسان، والهدف في الحالتين واحد وهو تحقيق مشروع استعماري بغيض للسيطرة على التاريخ والارض والمكان،وتغيير معالم البقاء والهوية لشعوب المنطقة.
2)تأثير ابادة المكان على البنية الاستراتيجية للبيئة المستهدفة وخياراتها في مواجهة العدو
بكل تأكيد يرتكب الاحتلال الإبادة الجماعية في غزة كما في لبنان اليوم، عبر ثلاث مستويات، هي الدمار الذي لحق بالبنية الفوقية أو جسم المدينة، واستهداف البنية التحتية التي تخدم كل العمليات الحيوية في المدينة، وتفكيك النسيج الاجتماعي الذي يعبّر عن العلاقات التي تربط الأفراد والجماعات ببعضها. يمكن التفكير بكل مستوى من هذه المستويات عبر أنماط التدمير الذي ذكرت سابقًا وهي الإبادة المادية أو الاستبدال ومحو الهوية أو السيطرة والتحكم، كما يمكن التفكير بها كوتيرة قصيرة المدى مثل لحظة سقوط الصاروخ أو القصف المدفعي، أو الاستهداف المتراكم طويل المدى الذي نلمس آثاره بعد أكثر من 500 يومًا من الحرب، وستظل آثاره ماثلة لما بعدها.
فمثلا، قد لا يوجد اليوم شارع واحد في غزة لم يشهد دمارًا، ولا حي لا يحمل آثار المتفجرات الثقيلة، صارت غزة مدينة من الركام حيث لا يمكن أن تقع عينك على مبنى غير مدمّر، تمثل هذه الأضرار ما لا يقل عن 65% من البنية الفوقية لغزة. إلى جانب الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية من الحصار ويجعلها أكثر بدائية من مثيلتها على بعد كيلومترات قليلة في المدن «الإسرائيلية» أو حتى مدن الضفة الغربية. دمّر الاحتلال في الحرب الحالية البنية التحتية، بما فيها إمدادات المياه المتمثلة في عشرات الآبار ومحطات التحلية والمعدات والخطوط الناقلة، وقطع 10 خطوط مزودة للكهرباء بالتزامن مع قصف مقر شركة الاتصالات الفلسطينية وعشرات الأبراج التابعة لها وقطع اتصالات الخطوط الأرضية وشبكات الإنترنت والهواتف النقالة. وأغلق الاحتلال أيضًا معبّر رفح، فيما انهارت المنظومة الصحية وتعطلت كل العملية التعليمية في غزة ودمرّت بنيتها التحتية المتمثلة في المدارس والجامعات. عطّلت الحرب معظم العمليات الحيوية الأساسية في القطاع، ما يؤثر على قدرة الناس على الصمود، فحتى لو بقيت بعض المنازل قائمة نسبيًا، فإن قدرة الأفراد مثلاً على استخدام الحمام في بيوتهم أصبحت مستحيلة مع غياب الصرف الصحي والمياه ومستلزمات النظافة الشخصية. هذه هي الإبادة المكانية التي وصفها وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت في العاشر من تشرين أول الماضي قائلًا إن «غزة لن تعود أبدًا إلى ما كانت عليه».
في لبنان، استخدم العدو الصهيوني الضربات التدريجية المركزة، فاستهدف القرى الامامية الحدودية ودمرها تدميرا كاملا لتكون مساحة مفتوحة تسهل الاجتياح، ثم عمد لضرب المدن والقرى الاخرى في الجنوب والبقاع وصولا الى الضاحية الجنوبية بتعلّة أنها مناطق انتشار للمقاومين، ولكن واضح أن المستهدف فيها هو بيئة المقاومة، اي البيئة الحاضنة لها.
بالتأكيد أن ممارسة ابادة المكان وسياسة قتل المدن لا تقل شراسة ولا عدوانية عن ابادة البشر وارتكاب المجازر باستهداف المباني المدنية ومراكز الايواء ومراكز الهيئة الصحية، ودور العبادة وغيرها، بل وضرب الطرق لقطع اوصال المناطق فيما بينها وصولا إلى بيروت العاصمة.
وفيما يتعلق بإثبات الإبادة المكانية أو التدليل عليها، يستخدم المعماريون والمخططون الصور الجوية وبيانات الغارات الجوية ونوعية الأسلحة المستخدمة، وبعض التقييمات التي تنشرها المنظمات الدولية، بالإضافة للقطات الكاميرات المثبتة على طائرات بدون طيار، ومقابلات عمال الإغاثة ومقدمي الرعاية الصحية وخبراء في الذخائر والحرب الجوية. والشكلة اليوم أنّنا ما زلنا لا نمتلك وصولًا فعالًا لهذه المصادر، إذ تقيّد الشركات التقنية الامريكية جودة لقطات الأقمار الصناعية أو إمكانية نشرها بحجة الكشف عن العمليات البرية للقوات الإسرائيلية. كما أن هذه اللقطات يجب أن تحلل بعناية شديدة وضمن سياقها، لا تقدّم لقطات الأقمار الصناعية مثلاً مشهدًا ثلاثي الأبعاد، ولذلك قد يختلف تعداد المباني السكنية في بعض الاماكن عن تعدادها في أماكن أخرى، وكذلك عدد الأشخاص المتضررين في كل منها.
إنّ تفكيك النسيج الاجتماعي بوصفه واحدًا من مستويات الإبادة المكانية التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي في حربه الحالية على غزة ولبنان.
الإبادة المكانية تشوّه أيضًا مشاعر الأفراد حيال أمكنتهم التقليدية؛ مدارسهم التي قضوا فيها أعوامًا يعيشون فيها اليوم كنازحين، دكانة الحي التي يبتاعون منها الحاجيات أصبحت رفوفها فارغة، شاطئ البحر الذي جلسوا عليه مع أصدقائهم ضاحكين تحيط به النفايات والمياه العادمة. استهدف الاحتلال معالم غزة الشهيرة كما المناطق اللبنانية منذ بدء القصف لتدمير ذكريات المدينة في أذهان أهلها. كما نبشت القوات الإسرائيلية مقابر الموتى وكتبت عبارات عنصرية على جدران المنازل التي تمركزت بها، وجرّفت الإسفلت من الشوارع المعبّدة.
لقد تغيرت علاقة الأفراد مع المدينة بالطبع، وفي واقع متسارع لا يتيح لهم استيعاب الصدمة، يصبح همّ الناس التركيز على إنقاذ حياتهم حتى لو كانت المدينة المحيطة بهم تعج بالجثث والدمار والخوف، حيث لا تصبح قدرتهم على الصمود مرتبطة برغبتهم بالصمود بقدر ما هي مرتبطة بعدم وجود خيار آخر. في غزة ومنذ بدء العدوان، وجراء تضرر شبكة النقل والطرق صار الناس يتنقلون بواسطة العربات التي تجرها الحمير بعد تضرر سياراتهم أو نفاد الوقود، هذه العربات صارت تنقل الجثامين والمصابين للمستشفيات أيضًا مع تعطل خدمات الإغاثة والدفاع المدني. يحاول الناس في هذه الظروف استخدام المتاح من الإمكانيات، لتغطية احتياجاتهم من الأكل والتنقل أو حتى الترفيه. ولذلك نشاهد مقاطع مصوّرة للأطفال يلعبون في حفرة خلّفها الصاروخ، ولأنشطة موسيقية يعقدها متطوعون في ساحات المدارس، ولحملات تنظيف شوارع المستشفى، هكذا يحاول الناس خلق شكلٍ من «الحياة العادية» تحت الحرب، حيث تصير الابتسامة أو كوب شاي ساخن أو الاستحمام إنجازًا، مقارنة بالوقت والظرف الذي يمرون به.
في فهمنا للعمارة واستهداف الاستعمار لها، علينا أن لا نفترض أن الفلسطينيين كانوا مجرد متفرجين حيال تدمير وتفكيك مدنهم وأراضيهم. تجسد توظيف العمارة في المقاومة حتى قبل عام 1948 عندما استخدم الفدائيون معرفتهم الحدسيّة المتأصلة بالمكان وشبكاتهم الاجتماعيّة لتأمين عمليات الكرّ والفرّ والهجوم والتمويه والاختفاء. في الحرب الحالية، فإن ثبات الفلسطينيين في غزة عمومًا وتمسكهم بالتواجد شمالي القطاع رغم القصف العنيف والتحذيرات المستمرة هو مواجهة للاحتلال لا تقل أهمية عن قدرة فصائل المقاومة الفلسطينية على التحرك عبر الأنفاق أو إطلاق صواريخ محلية الصنع واختراق المجال الجوي الذي ظلت «إسرائيل» تحتكره لسنوات.
من هنا، نستنتج الاهداف العسكرية والسياسية التي يسعى الاحتلال لتحقيقها من خلال الابادة المكانية لغزة ولبنان في هذه الحرب. حيث تساعد الإبادة المكانية الاحتلال الإسرائيلي على تحقيق بعض أهدافه العسكرية كالتالي:
-القصف السجّادي، وهو تكتيك عسكري لقصف منطقة عبر القنابل غير الموجهة بكثافة وتدميرها بالكامل حتى تتسطّح معالمها، وهو يرتبط بقيام الاحتلال بفتح ممرات مكشوفة للآليات العسكرية بالتزامن مع بدء العملية البرية أو قبلها. يمنح القصف السجادي جنود الاحتلال قدرة أكبر على المناورة والسيطرة، مقابل مقاتلي المقاومة الذين يحاولون استدراجهم للمباني السكنية التي تمنحهم الأفضلية في استخدام الشبابيك والسلالم والتنقل عبر الغرف.
من ناحية أخرى، جزء كبير من حرب الاحتلال الحالية على غزة أو لبنان يهدف إلى تدمير البنية التحتية الخاصة بالمقاومة، ولأن جزءًا من شبكة الأنفاق مرتبط بفتحات في البنية الفوقية داخل المباني، يقوم الاحتلال باستهداف المنازل لقطع هذا الاتصال بين الفضائيْن أو لقتل أي أفراد محتملين داخل الأنفاق.
-تحقق الإبادة المكانية أيضًا أهدافًا سياسية، إذا لم يفلح مسح مربع سكني كامل في تدمير نفق أو اغتيال قيادي، فإنه بالضرورة سيقتل عشرات الشهداء من المدنيين وسيدمر أي إمكانيات للحياة يحتاجها المواطنون، ويحاول بذلك دفعهم إما للهجرة أو النزوح، أو لفظ المقاومة والانتفاض عليها.
-قصف الاحتلال أماكن لا يحتمل تواجد المقاومين فيها مثل آبار المياه والمستشفيات ومراكز الإيواء، لكنه بتعظيم المأساة الإنسانية يجبر البيئة الحاضنة على تغيير أماكنهم بحثًا عن احتياجاتهم التي يستخدمها كأداة حرب، و/أو يدفعهم ليصبحوا في قمة السخط على المقاومة التي ينخرط العدو في محاربتها.
يتّضح الدمار الّذي تسبّبه الهجمات الإسرائيليّة بكلّ فداحة إذا ما قارنه المرء بقطاع غزّة مساحة، باعتبارها – المساحة – العتبة الأولى لفهم المكان وما يحدث فيه. يحتلّ القطاع مساحة 360 كم مربّعًا من الأرض – أي ما يعادل ربع مساحة بلديّة روما، أو نصف مساحة برلين – الّتي تستضيف مدنًا عدّة أهمّها مدينة غزّة، وخان يونس ورفح، الّتي تشكّل مع ذلك منطقة حضريّة واحدة من وجهة نظر وظيفيّة. يسكن في القطاع أكثر من مليونَي شخص في ظروف اقتصاديّة صعبة، يزدحمون على هذه القطعة من الأرض. وقد ارتفع مستوى الفقر في القطاع من 40% في عام 2007 إلى 56% في عام 2017 وفقًا لـ «الأمم المتّحدة». في غياب الحصار والصراعات العسكريّة، كان مستوى الفقر في عام 2017 سيكون 15%، في ما معدّل البطالة أكثر من 40%.
في مواجهة الغارات الجوّيّة الهستيريّة، بترسانة نوعيّة من الأسلحة، ستكون إعادة الإعمار تحدّيًا كبيرًا؛ إذ لا يملك سكّان القطاع ومؤسّساته ما يكفي من الموارد الاقتصاديّة المحلّيّة لتعزيز عمليّة إعادة الإعمار، الّتي تعتمد بالتالي كلّيًّا على التمويل الدوليّ، وخاصّة من أوروبّا والولايات المتّحدة والدول العربيّة. وغالبًا ما تُسْتخدَم أداةً للابتزاز السياسيّ، كما أنّ القطاع لا يملك الموارد المادّيّة الّتي لا غنى عنها؛ أي الوسائل وموادّ البناء. في الواقع، تسيطر إسرائيل وترشّح وتحدّ من كلّ ما يمكن أن يدخل القطاع. يشمل ذلك موادّ البناء، الّتي تحظر سلطات الاستعمار الإسرائيليّ استيرادها بحجّة إمكانيّة استخدامها لأغراض حربيّة، وقد عوّض سكّان قطاع غزّة ذلك في بعض الأحيان بالإبداع، على سبيل المثال، عن طريق استخراج موادّ البناء من تحت الأنقاض، وقد استخدموا الأنفاق لإدخال كمّيّة كبيرة من موادّ البناء إلى القطاع. ومع ذلك، من الواضح أنّ هذه الحلول لا يمكن أن تدعم عمليّة إعادة إعمار منهجيّة، وفي الوقت المناسب، بحيث يضيف كلّ قصف أنقاضًا جديدة إلى ما لمّا يُعَد بناؤه بعد، في دوّامة من الإبادة المتزايدة للفضاء الحضريّ.
ستواجه لبنان نفس المعضلة بعد انتهاء الحرب، فملف اعادة الاعمار ملف مغري للكثير من الاطراف الاقليمية والدولية ولعله سيكون ايضا من اكثر الملفات حساسية وخطورة في المرحلة المقبلة. ويبقى السؤال الاهم هل بامكان محاسبة هذا العدو عن الابادة المكانية وقتل المدن كما ابادة البشر؟ هل العدالة الدولية قادرة فعليا على فعل ذلك في ظل الضغوط والممارسات وسياسة الابتزاز التي يستخدمها حلفاء هذا العدو وداعموه الدوليين؟
بالمحصلة، إنّ ابادة المدن وقتل التاريخ والحضارة والهوية لا تقل في تصنيفها اجراما وانتهاكا عن الابادة الجماعية للانسان وللاجساد، فكلاهما ممارسات مرفوضة وكلاهما انتهاكات لكل المواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية الحقوقية والانسانية وكلاهما جرائم تستوجب وقفة، بل صرخة حقيقية لمحاسبة العدو الذي يمارس ساديته واستراتيجيته التلمودية ليس فقط بالتدمير الممنهج بل باحتلال الاراضي وطمس معالمها الاصلية وهويتها وتاريخها واجبار اصحابها الحقيقيين على الهروب والنزوج بلا عودة….ولن يفلحوا.
* الخنادق