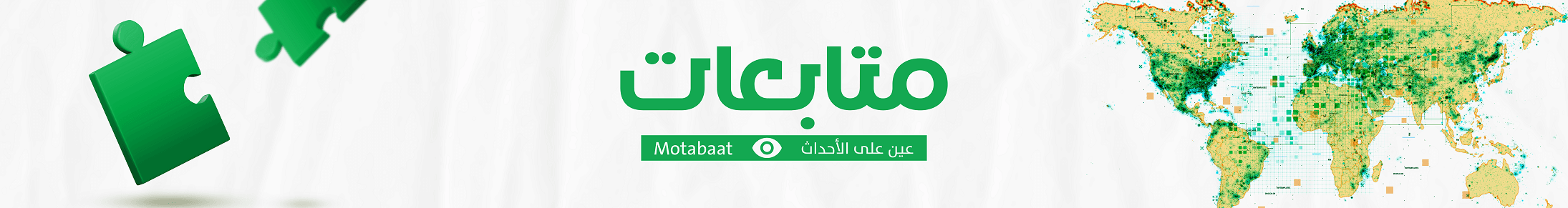واشنطن بوست تحث واشنطن على تجنب التورط في تحالفات عسكرية مع السعودية و”إسرائيل”
واشنطن بوست تحث واشنطن على تجنب التورط في تحالفات عسكرية مع السعودية و”إسرائيل”
متابعات:
بعد الهجمات الأخيرة على منشآت النفط السعودية، يبدو أن الرئيس “ترامب” تصرف من منطلق أن العلاقة الدفاعية طويلة الأمد لواشنطن مع الرياض تعني أن الولايات المتحدة يجب أن تقدم المساعدة، وأذن بنشر قوات أمريكية صغيرة في المملكة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، غرّد “ترامب” بأنه كان يناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” إمكانية إبرام معاهدة دفاعية أمريكية إسرائيلية رسمية.
لكن هل من المهم ألا تكون “إسرائيل” أو السعودية حليفا رسميا في معاهدة مع الولايات المتحدة؟ نعم، وإليكم السبب.
في أعوامها الأولى.. ابتعدت أمريكا عن التحالفات
بين حرب الاستقلال وأوائل فترة الحرب الباردة، لم تقم الولايات المتحدة بإبرام تحالفات عسكرية رسمية إلا عندما اعتقدت أن بقاء أمريكا يتوقف عليها، ودخلت في اتفاقين دفاعيين فقط خلال المعركة من أجل الاستقلال عن بريطانيا وأثناء الحرب العالمية الثانية.
ودفعت الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة إلى تغيير جذري في النهج الأمريكي للعلاقات الدولية في زمن السلم، واعتقد مخططو ما بعد الحرب أن البلاد لم تعد قادرة على الاعتماد على ميزتها الجغرافية، وبدلا من ذلك، احتاجت الولايات المتحدة إلى استراتيجية للدفاع الأمامي لمواجهة التهديدات في الخارج، أي الاتحاد السوفييتي والصين وكوريا الشمالية.
وبين عامي 1948 و1955، أبرمت واشنطن، التي كانت في السابق خائفة من التحالفات، اتفاقات أمنية متفاوتة من حيث القوة والالتزامات مع 23 دولة في أوروبا وآسيا، مع منطق أن هذه التحالفات قد تساعد واشنطن في درء النزاعات في الخارج والدفاع عن نفسها، وشمل هذا تشكيل حلف شمال الأطلسي “الناتو”، والاتفاقيات مع اليابان وكوريا الجنوبية وجمهورية الصين (قبل النظام الشيوعي) والفلبين وأستراليا ونيوزيلندا.
وبحلول فجر القرن الحادي والعشرين، كانت الولايات المتحدة قد تحالفت مع 37 دولة، ووقعت عددا كبيرا من معاهدات الدفاع المتبادل، وهو ميثاق رسمي ينص على أن الهجوم ضد الحليف سيتم التعامل معه على أنه هجوم على الجميع، أو يتم التعامل معه على أنه تهديد لسلام وأمن الجميع.
وقد اختلفت لغة المعاهدة بين الحين والآخر إلى حد ما عبر التحالفات الأمريكية، لكن الوعود الجوهرية ظلت متشابهة، ولم تتعهد واشنطن بأي حال من الأحوال أنها سترد عسكريا على استخدام القوة العسكرية ضد أي حليف.
وبدلا من ذلك، من خلال إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة الدفاعية وتعزيز التنسيق الدفاعي، تزيد معاهدات الدفاع المتبادل من اعتقادات الحلفاء والخصوم أن الولايات المتحدة ستقدم المساعدة “العسكرية” لشركائها. ويسمي الاستراتيجيون هذا النهج بـ “الردع الموسع”؛ حيث تحبط الولايات المتحدة الهجوم على دولة أخرى حليفة من خلال توقيع معاهدة دفاعية معها.
وقد حقق هذا النهج من التحالفات نتائج مثيرة للإعجاب؛ فلم يكن أي من حلفاء الولايات المتحدة ضحية لهجوم كبير على الإطلاق، ومن الصعب أن نقول على وجه اليقين أن هذا كان حصرا بسبب “الردع الموسع”، لكن من المعقول أن التحالفات الأمريكية لعبت دورا في ذلك.
دلالات الإحجام عن التحالفات
خلال نفس الفترة، شكلت واشنطن أيضا شراكات دفاعية أخرى لا تعتمد على معاهدات الدفاع المتبادل مع كيان مثل “إسرائيل” ودولة كالسعودية، ومع تايوان، ألغت الولايات المتحدة تحالفا رسميا في عام 1979، واستبدلت به قانون العلاقات مع تايوان.
وتعتمد هذه الشراكات على مبيعات الأسلحة والتنسيق الاستخباراتي والعلاقات السياسية الوثيقة، لكنها بحكم التعريف، ترسل إشارات أضعف حول قوة التحالف مقارنة بمعاهدات الدفاع المشترك. وبحكم الواقع، تميز السياسة الأمريكية هذه الفئة من الحلفاء عن غيرهم من الشركاء.
ومما يعزز هذا التمييز حقيقة أن صانعي السياسة الأمريكية اختاروا منذ ذلك الحين عدم توقيع معاهدات دفاع متبادل، وعلى مر السنين، تغير موقف الاستراتيجيين الأمريكيين من تقدير هذه التحالفات إلى معارضتها. ومن عام 1961 إلى 1963، أدركت إدارة “كينيدي” أن “إسرائيل” قد بدأت السعي للحصول على أسلحة نووية، وفكرت جديا في مد “إسرائيل” بضمان أمني رسمي عبر توقيع معاهدة دفاعية معها لإقناعها بالتخلي عن سعيها.
وقبل وقت قصير من اغتياله، قرر “جون كينيدي” وكبار مساعديه أن توقيع هذه المعاهدة يعد أمرا بالغ الخطورة؛ حيث شعروا بالقلق أن “إسرائيل” ستجر الولايات المتحدة إلى حرب مع مصر، التي لم تراها واشنطن خصما في ذلك الوقت.
ودون النظر في معاهدة للدفاع المتبادل الكامل، سعت إدارة “أوباما” أيضا إلى رفع مكانة شراكتها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الفارسي الأخرى، معترفة بأن التحالف الرسمي سيكون محفوفا بالمخاطر.
الولايات المتحدة تفضل الشراكات على التحالفات
وقد تساعد الطريقة التي يختار بها صانعو السياسة الأمريكية الحلفاء في شرح سبب نجاح اتفاقيات واشنطن. وعلى الرغم من الانتقادات الشائعة التي تصم الحلفاء بأنهم “سائقون متهورون”، فإن الحلفاء التي وقعت معهم أمريكا المعاهدات لا يميلون إلى جرها إلى حروب غير مرغوب فيها.
وربما يرجع ذلك إلى أن صانعي السياسة كانوا انتقائيين للغاية، فعندما يخشون أن يجرهم الحلفاء الجدد إلى الصراع، فإنهم يقيدون وعودهم في هذا التحالف للحد من هذا الاحتمال، ويستخدمون صيغة التحالف نفسها لإدارة هذه المخاطر. وعندما تورطت الولايات المتحدة مع دول أخرى في حروب أو أزمات، فقد كانت هذه الدول عموما شركاء أمنيين وليسوا حلفاء رسميين، ربما لأن العلاقة الأقل رسمية ترسل إشارات غامضة، ما يجعل من الصعب ردع الخصوم وكبح الشركاء.
وباستثناء عملية توسيع حلف شمال الأطلسي بعد الحرب الباردة، لم تدخل الولايات المتحدة في تحالف أمني رسمي جديد منذ عام 1955، وتعد هذه التحالفات خطوة صعبة إلى حد ما؛ حيث تتطلب معاهدات التحالف تصديق ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ويجعل الاستقطاب السياسي من الصعب التصديق على المعاهدات.
ويوجد دعم ساحق من الحزبين لـ”إسرائيل” في الكونغرس، وعلى الرغم من أن تغريدة الرئيس حول توقيع “معاهدة دفاعية” مع “إسرائيل” ربما كانت خدعة لمساعدة “نتنياهو” قبل الانتخابات الإسرائيلية الصعبة، لكنه من الصعب استبعاد احتمال أن يكون جادا، وقد يدعمه الكونغرس.
لكن فرص السعودية في تحالف رسمي مع الولايات المتحدة ليست واعدة بالقدر الكافي، لأن مجلس الشيوخ لا يزال يشك في دور الرياض في مقتل الصحفي “جمال خاشقجي”.
لكن التحالف مع “إسرائيل” ينبغي أن يثير الكثير من الحذر في واشنطن، وقد أصبحت البلاد قومية بشكل متزايد، وأكثر ميلا إلى التصعيد العنيف، ولا يعني مجرد ضم “إسرائيل” إلى تحالف رسمي بالضرورة منح واشنطن سيطرة كافية على قرارات “إسرائيل”.
وتاريخيا، أظهر مجلس الشيوخ تدقيقا جديا في معاهدات التحالف الجديدة، ولكن بمجرد التصديق على المعاهدة، يحتفظ الرئيس بسلطة شبه فردية في إدارة التحالف، وإذا استمرت رغبة “ترامب” في إبرام معاهدة لـ “الدفاع المشترك” مع “إسرائيل”، فقد يقرر الكونغرس تقييم مخاطرها.
وبالنسبة للسعودية، يعد نشر القوات بمثابة تذكير بأن الولايات المتحدة قد تتورط مع الشركاء، حتى لو كانت العلاقة لا تتضمن معاهدة للدفاع المتبادل.