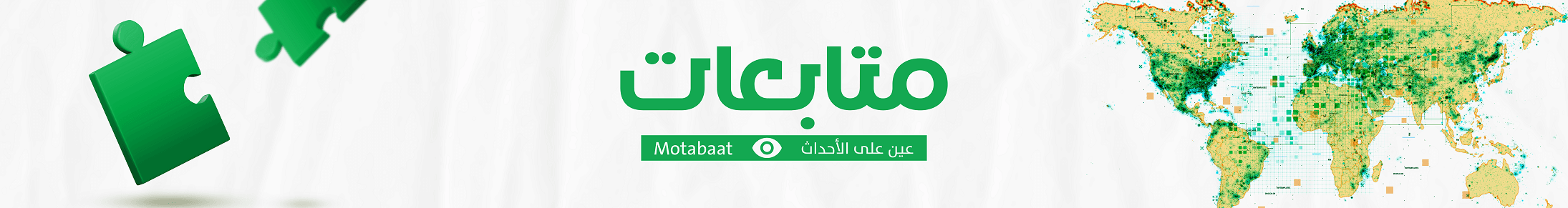واقعُ المنطقة بين عالمين: مقاومٌ أمام الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية ومقاتِلٌ في ركبها
تحليل: إبراهيم مالك*
عندَ القيام بأيَّةِ محاولة لفهم وتحليل ما يجري في الجزء الذي نعيش فيه من العالم، يجبُ أن لا يغيبَ عن حُسبانِنا أن دوامَ حالة الحرب والصراع العنيف وأجواء العسكرة على تفاصيل المشهد السياسي فيها ليس وضعاً استثنائياً وحالة شاذة، بل إن ذلك يعني أن منطقتنا على حالتها التي ينبغي أن تكون عليها وفق التقسيم السياسي والاقتصادي لمناطق العالم الذي تحدده مصالح «الإمبراطورية الأميركية»، فمنطقة الشرق الأوسط وما حولها هي أكبر ميدان رماية في العالم.
مصلحةُ الأميركيين تقاطعت في العدوان ضد اليمن مع طموحات الابن المدلل الذي رأى طريقَه إلى العرش السعودي يمُرُّ على عظام اليمنيين، فقرّر الطرفان حملةً عسكريةً اعتقدا أنها ستكون خاطفة مثل ألعاب «البلايستيشن»
لا يزال العالمُ العربيُّ يعيشُ في وضعِه السياسي والثقافي والاجتماعي في ظل تداعيات النكسة سنة ٦٧ والنظام الإقليمي الذي تأسس إثرها، وهو على ارتباط وثيق وجزء لا ينفصل عن المنظومة الغربية الرأسمالية بقيادة أميركا، وقد جاء ضمن سياق التحولات البنيوية التي كان يمر بها النظام الدولي من صعود للنموذج النيوليبرالي وبداية تراجع النزعة التحرّرية – سياسياً وثقافياً وعلى الصعد كافة – التي اجتاحت دول العالم الثالث تمهيداً لسحقها في عملية طويلة لا تزال مستمرة إلى حاضرنا. والنظام الإقليمي الذي تأسس منذ ذاك اليوم يقوم على ركيزتين أساسيتين، ترتبطان بالإسهام المرتقب منه تجاه النظام العالمي، وهما:
أولاً: دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، بوصفها قاعدةً عسكريةً وأمنيةً متقدمة زُرعت في قلب المنطقة، ونموذجاً حياً على انتصار قيم الحداثة الغربية على الثقافة المتخلفة التي ترزح تحت وطأتها الشعوب والدول العربية.
ثانياً: النفط العربي في منطقة الخليج، وتمثله السعودية؛ كونها أكثر هذه الأنظمة ثروةً في ما يتعلق بالمساحة والموقع الجغرافي والنفط كمورد طبيعي.
ما دفع السيدُ حسين الحوثي إلى التحَــرّك سببان: مواجهةُ الهجمة الأميركية ضد العالم الإســـلامي بعد هجمات الـ11 من أيلول، والتصدي للنفوذ الوهابي الذي بدأ بغزو البلاد بدعم من السعودية وحليفها المحلي الحاكم
وإذا كان الاستيطان الصهيوني لفلسطين قد شكّل الركيزة الأولى في بسط الهيمنة الأميركية على المنطقة العربية في مرحلة ما بعد النكسة، فإنّ المملكة السعودية شكّلت الركيزةَ الثانيةَ لذلك؛ بفعل ما يقبع في باطنها من ثروة نفطية هائلة مسخّرة لخدمة الأميركيين، والنظام الاقتصادي الذي يعمل لصالحهم عندما يتم تسعير أهم مورد للطاقة في العالم بعملة الدولار.
هاتان القاعدتان الأساس في النظام الإقليمي الذي تشكّل في العالم العربي، بعد أن خَبَتْ شعلةُ النظام الناصري في مصر في ظل التراجُعِ العالمي الذي مُنيت به الكثير من حركات التحرر في عالم الجنوب، بعد أن كانت تشكّل متنفّساً للشعوب والمجتمعات المستضعَفة.
«هذه المنظومةُ التي استولدتها الهزيمة وتطوّرت تدريجياً في أعقاب عام ١٩٦٧» يكتب سيف دعنا «كانت الرد الأكثر تشوّهاً على هزيمة العرب القاسية حينها، إن لم تكن الاستجابة الأكثر مثالية والتنفيذ الأكثر أمانة لشروط الهزيمة. كان تَشَكُّلُ هذه المنظومة الرسمية، وهيمنةُ آل سعود عليها تدريجياً، من أخطر آثار الهزيمة والعدوان، إن لم يكونا أخطرها على الإطلاق».
كان السيدُ الحوثي وتياره الجهةَ الوحيدةَ في الشمال التي وقفت علانيةً مع أبناء الجنوب في حرب ١٩٩٤، وهو حدثٌ لا تزالُ آثارُه مخيمةً على الواقع السياسي في اليمن
الشرخ الأول
«قبل ٣٥ عاماً قُتل ٢٤١ من جنود المارينز والبحارة والجنود في بيروت بلبنان، على يد [إرهابي] من حزب الله درّبه الإيرانيون. لن ننسى أبداً هؤلاء الأبطال الذين جاؤوا بسلام وفقدوا حياتهم في ذلك اليوم المرعب»، تغريدة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بعد زيارته الأخيرة لبيروت.
بعد أن شعر الإسرائيليون بالاطمئنان إلى أنه صار لهم في الأراضي الفلسطينية موطئُ قدم ثابتٌ وأن الشرق الأوسط قد دخل العصرَ الإسرائيلي، رأوا أنه حان الوقتُ للاستيلاء على عاصمة عربية ثانية، ولتكن في البلد الذي تتحَــرّك منه المنظماتُ الفدائية والمقاومة الفلسطينية لتنفيذ عملياتها ضد الكيان، فاقتحم الجيشُ الإسرائيلي – الذي لا يُقهر- العاصمة بيروت وتحوّل لبنان إلى ساحة قتال بين إسرائيل وسوريا وفصائل المقاومة الفلسطينية، وحضر الأميركيون والفرنسيون بقواتهم من البحر ليتخذوا لهم مقرات دائمة في هذا البلد وضمّه إلى القواعد الثابتة التي يتحَــرّكون منها في المنطقة. في هذه اللحظة التأريخية كانت هناك مجموعة من الشباب المجهولين، كانوا خارج حسابات القوة وصناعة القرار، يحضرون للأميركيين والقوات المتعددة الجنسيات والإسرائيليين وأساطيل الغزاة ما يحسن معه ألا ينسوا يوم لقائهم الأول معهم. كان هذا اليوم الأسود في عيون بومبيو هو من باكورة الأعمال الجهادية لعماد مغنية والسيد مصطفى بدر الدين ورفاقهما. والبدايةُ التدريجيةُ لنهاية إسرائيل والتصدع الأول الذي ظهر على كيان النظام الإقليمي الجديد وأول انتكاسة تواجه مشروعَه، إلى أن يتشقق جداره بالكامل وينهار على وَقْع انتصار التحرير في عام ٢٠٠٠ وإعلان السيد حسن نصر الله أن «إسرائيل هذه أوهن من بيت العنكبوت» ثم تتجذر هذه المعادلة بعد انتصار تموز ٢٠٠٦ المذلة للجيش الإسرائيلي والتي على أساسها يتحول «حزب الله» من مقاومة محلية لتحرير الأرض إلى القوة الإقليمية الرئيسية لإفشال خطط الهيمنة الأميركية في بلادنا، كما كان دوره في الحرب على سوريا.
أسوأ ما يريدُ أن يفرضَه علينا الأمير الشاب، هو التماهي مع الخفة العقلية والكارثة الأخلاقية الملازمة لمشروعه.
وفي مكانٍ آخرَ من العالم العربي، في هذه الأثناء -سنة ٢٠٠٢ تحديداً-، كان السيد حسين الحوثي في جامع الإمام الهادي في صعدةَ يتابعُ تجربةً المقاومة بتهلُّلٍ واستبشار، ويرى في تحَــرّكها، لمقاومة آلة الاحتلال الجبارة بأقل الإمكانات وفي أصعب الظروف، حُجَّةً لغيرهم لئلا يركنوا إلى السكينة والانكفاء أمام الهجمة الأميركية الشرسة على العالم الإسْـــلَامي بعد تفجيرات الحادي عشر من أيلول. وهنا تبدأُ قصةُ الشرخ الثاني في المنظومة العربية الرسمية.
السيدُ حسين الحوثي لم يبدأ التحرُّكَ إلا على أساس وعيه بخطورة المرحلة المفصلية على الواقع الذي تعيشه الأمة
قصةُ اليمن وشيخُ ضبة
اندلع عددٌ من الانتفاضات والتحَــرّكات المطلبية عام ٢٠١١ في أنحاء مختلفة من العالم العربي، بعد أن تمكّن المحتجّون في تونس من تنحية زين العابدين بن علي من منصبه في الرئاسة. كان شعورُ ممالك الخليج منذ البداية، تجاه هذه الموجة وهذه التحَــرّكات في أكثر من بلد، متوجساً عدائياً؛ خوفاً من أن يطالَها بعضُ التغيير في طبيعةِ نظامها السياسي. إلى أن تأكّـــدت لها هذه المخاوفُ مع انطلاق الانتفاضة الشعبية في البحرين في ١٤ فبراير وبدء الاعتصام في ميدان اللؤلؤة في العاصمة المنامة.
التحَــرّكُ كان كبيراً بالنسبة إلى بلد بمثل مساحة البحرين وعدد سكانه، وحدث ارتباكٌ وقلقٌ داخل الأسرة الحاكمة دعاها إلى القيام بمناورات سياسية لتهدئة الوضع وتقديم الوعود ببدء حوار شامل والتفاهم مع المحتجّين وبدأت بالفعل بالتحضير العملي لتنفيذ هذه المناورات. حتى أتتها الأوامرُ من الجارة الكبرى تحذّرها فيها من تقديم أيِّ تنازل، وأنها ستقدّمُ مع الإمارات قواتِ دعم لسحق هذا التحَــرّك المطلبي والقضاء عليه نهائياً. اليوم يقبعُ أكثرُ الناشطين السياسيين والحقوقيين البحرينيين في السجن، ومن لم يكن خلف القضبان يعِشْ في المنفى، ويصدر ملكُ البلاد كلَّ عام قراراً بتجريد المئات من المواطنين من جنسيتهم (في نيسان / أبريل الماضي أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى حكماً بتجريد ١٣٨ متهماً من جنسيته، وبهذا يصل عدد من جرّدتهم السلطات البحرينية من الجنسية إلى أكثر من ٩٥٠ شخصاً، قبل أن يقرّر الملك أن يثبت جنسية ٥٥١ شخصاً منهم!)، ويعيش الأجانبُ فيه أعلى حالات الرفاهية والنعيم (كشف تقرير بلومبيرغ عن قائمة البلدان الأفضل معيشة للأجانب على مستوى العالم، حيث كانت البحرين في الصدارة متفوقة على كُـــلّ البلدان).
كُـــلُّ هذا نتيجة أن تحرُّكَ البحرينيين كان في منطقة حساسة ومؤثرة بالنسبة إلى الوجود الأميركي في المنطقة، ما يبرّر أن يتم سحقُهم كلياً وتشريدهم من بلدهم واستبدالهم في سوق العمل بوافدين من أنحاء العالم كافة لمنحهم الجنسية.
على الهامش: البحرينيون من أكثر الشعوب العربية تفاعلاً مع القضايا الإسْـــلَامية والعربية، منذ خمسينيات القرن الماضي إلى اليوم، ويملكون من الوعي والشعور العالي بالمسؤولية وتشخيص حقيقة الصراع في المنطقة ما عجز عن امتلاكه غيرُهم، يكفي الاستماع إلى قصائدهم وما تتضمنه من رسائلَ سياسيةٍ يدسونها في القصائد، وهذا ما كان نقمة عليهم ودعا السلطات إلى التفكير في حلول جذرية لتحييد السكان الأصليين عن الشأن العام في البلد، تحييداً يمكّنها من أن تكونَ المنصةَ التي توقّع عليها صفقة العار في هذا القرن.
التحرُّكُ السعودي الإماراتي ضد البحرينيين تحتَ مسمى «قوات درع الجزيرة»، كان أولَ تحرّك ميداني للكتلة ضد خطر يواجه أحد أضلاعها بعد أن كانوا مجرد آبار بترول ومنصة نشر كراهية وفكر محرّف عن الإسْـــلَام وخزينة لتوفير السيولة. والتحرُّكُ الثاني لهم كان في اليمن ضد ثورة أنصار الله في ما يسمى «عاصفة الحزم».
عندما بدأ السيدُ حسين بدر الدين الحوثي نشاطَه الثقافيَّ والتوعويَّ في مران من صعدة، كان ما دفعه إلى ذلك سببان بشكل رئيسي، هما: مواجهةُ الهجمة الأميركية ضد العالم الإسْـــلَامي بعد هجمات الحادي عشر من أيلول، والتصدي للنفوذ الوهابي الذي بدأ بغزو معقل الزيدية التأريخي شمال البلاد بدعم من السعودية وحليفها المحلي الحاكم. وهو لم يبدأ هذا التحرُّكَ إلا على أساس وعيه بخطورة تلك المرحلة المفصلية على الواقع المحلي الذي تعيشه بلاده، بعد انتهاء سنين نشوة انتصار الرأسمالية الغربية بقيادة أميركا على أكبر خطر كان يهدّدُ نموذجَها على المستوى الدولي، متمثلاً بالاتّحاد السوفياتي، وبدء عصر جديد يتطلب عدواً من نوع مختلف، هو الإرهاب. هذا بالتالي يجعل من البلدان الممتدة من وسط آسيا إلى الحوض الشرقي والجنوبي للبحر المتوسط منطقة ساخنةً بالنسبة إلى التغيرات التي ستحصل في النظام الدولي، بما لكُلِّ هذه التغييرات من تأثير يطالُ الواقعَ السياسي والاقتصادي والثقافي والعسكري للناس في هذه المنطقة. وكان اليمنُ من أكثرَ البلدان سخونة وتأثراً بهذه التغيرات، ونقطة تغيرات حرجة تحدث على مستوى عنيف بالنسبة إلى السياسة الاستعمارية الجديدة على المستوى الدولي (وجود عسكري أميركي وقاعدة استخبارات وسياسة اقتصادية مدمّـــرة) والمستوى الإقليمي (في نشر الوهابية وتدمير الحياة السياسية والاجتماعية). من هنا أطلق السيد حسين الحوثي صرخته «الصرخة في وجه المستكبرين» -التي لا يزال يرددها المقاتلون اليمنيون بعد تحويل كُـــلّ قطعة من أسلحة التحالف إلى خردة- استناداً إلى قراءته الدقيقة للواقع العالمي والمحلي وتأثيره المنعكس على بلاده، وانطلاقاً من رؤيته حول موقع القرآن الكريم في الحياة والتجارب الحية في المنطقة كالإمام الخميني و«حزب الله» والمقاومة في فلسطين، رأى أن مسؤوليتَهم الإيمانية والوطنية أن يضعوا خطةً عمليةً لمواجهة هذا التحَــرّك وأن لا يغمضوا أعينهم عن خطورة ما ينتظرهم. وعليه كان من أكثر الأفكار التي أكّـــد عليها السيد الحوثي وجعلها ثالثَ شعارات مجموعته، إلى جانب الصرخة في وجه المستكبرين وشعار مقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية، هي أن أفراد تنظيم «القاعدة» هم عناصر استخبارات أميركية وإسرائيلية، وعليهم أن يقاتلوهم على هذا الأساس وضمن تحَــرّكهم لمواجهة المشروع الأميركي الإسرائيلي في المنطقة. (يُراجع للتوسع أكثر حول هذا الموضوع كلمة السيد عبدالملك الحوثي عام ٢٠١٨ في الذكرى السنوية للصرخة، وملزمة «خطر دخول أميركا اليمن» للسيد حسين).
على الهامش: كان للسيد حسين وعموم محيطه تجربة سياسية سابقة في دولة اليمن الحديثة، وقد شارك حزبُه وفاز في انتخاباتِ مجلس النواب عام ١٩٩٣ مع رفيقه الشيخ عبدالله بن عيضة الرزامي -شيخ قبائل همدان بن زيد التي كانت أول من بدأ الرد على التحالف بعد ٤٠ يوماً من العدوان- وكانوا الجهةَ الوحيدةَ في الشمال التي وقفت علانية مع أبناء الشطر الجنوبي في وجه حرب ١٩٩٤، وهو حدثٌ لا تزالُ آثارُه مخيمةً على الواقع السياسي في اليمن.
بين انطلاقة الحركة في ٢٠٠٢ وثورة ٢١ أيلول/ سبتمبر في ٢٠١٥، لم يتوقف «أنصار الله» عن خوض المعارك يوماً. في ست حروب بينهم وبين السلطة، تواجهوا في آخرها مع الجيش السعودي أدّت القيادة السعودية خلالها أداءً مريعاً. وبعد هذه الحروب الست لم يتوقف فتح الجبهات ضدهم بتحريض من السفير الأميركي في صنعاء، وكان أنصار الله – فيما يشيع الأميركيون ووسائل الإعلام الغربية وهوليوود أن اليمن «أحد ساحات حربهم على الإرهاب»- يطاردون «القاعدة» من محافظة إلى أُخْـــرَى. فنشأ جيلٌ كاملٌ متمرسٌ على القتال في الظروف كافة، يحمل فكرة واضحة عن الهدف الذي يقاتلُ لأجله ويعلمُ مدى الصعوبات والمخاطر التي سيتكبّدها في سبيلِ تحقيق هذا الهدف.
وتصادفُ مع انتصار ثورة ٢١ أيلول/ سبتمبر وفاة الملك عبدِالله وتولّي سلمان الحكم ومن خلفه نجله الطامح إلى تبوّء العرش، وقد تقاطعت مصلحةُ الأميركيين في شن حملة ضد أنصار الله، بعد أن فرّ سفيرُهم من العاصمة تزامناً مع سيطرتهم عليها، مع طموحات الابن المدلل الذي رأى أن طريقَه إلى العرش يمُرُّ على عظام اليمنيين. فقرّر الطرفان أن يبدآ حملة عسكرية اعتقد السعودي أنها ستكون خاطفة وسريعة مثل ألعاب «البلايستيشن» وحملات مسلسل «ون بيس» الذي يُحِبُّه ضد أعدائه، وأقدم على ذلك بالاشتراك مع ولي عهد أبوظبي -الذي يُكِنُّ ابن سلمان له كُـــلَّ الإعجاب والتقدير- في حملة تسببت في أسوأ كارثة إنسانية شهدها العرب في تأريخهم الحديث ولا تزال مستمرةً في عامها الخامس.
آخرُ نتائج هذه الحملة ضد الشعب اليمني -المنطلقة على أساس أنها ستنتهي في أسبوع بطرد أنصار الله من صنعاء واقتحام صعدة- هي عقدُ ثلاث قمم -على المستوى الخليجي والعربي والإسْـــلَامي- تحت عنوان الدفاع عن أمن الحرمين وحماية الكعبة من أن تُهدم. دُعي إلى المشاركة فيها أعضاء مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسْـــلَامي، حيث ينزلون إلى مطار جدة ويستعرض عليهم المتحدث باسم التحالف صواريخ الجيش اليمني واللجان الشعبية وطائراته المسيرة.
أعتقد أن أسوأ ما يريد أن يفرضُه علينا الأمير الشاب، هو التماهي مع الخفة العقلية والكارثة الأخلاقية والبذاءة الفكرية الملازمة لمشروعه ومسايرة أحلامه، التي تتبدى لنا في المفارقات المليئة بها إخفاقاته وفشله الذريع في مغامرته الطموحة والمتهورة في اليمن لإرضاء نهمه وتحقيق رغباته: ففيما يعلن المتحدثُ باسم تحالفه أنهم دمّـــروا مخزون الصواريخ الباليستية في أول شهر من العدوان قبل ٤ سنوات، ودمّـــروا الشبكةَ الخاصةَ بالقدرات والمرافق اللوجستية للطائرات المسيّرة عند الجيش اليمني قبل شهرين، يقيم معرضاً قبل أيام أمام مسؤولي الدول العربية والإسْـــلَامية ليضُجَّ أمامهم بالعويل والبكاء والشكوى من رد اليمنيين القاسي عليهم بهذه الأسلحة. وفيما ينفذ التحالف المجازر بقصفه للأحياء السكنية وباصات المدارس والمستشفيات، يخرج لنا هذا المتحدث ليلقي تهمة القيام بذلك على اليمنيين أنفسهم.
أو بعبارة أُخْـــرَى القبول بالعيش وفق معايير عالم تعتمد شروطَ بقائك فيه على مسايرة الأثرياء والانجرار خلف نزواتهم، ولو كانت نزواتهم يعني أن تصفقَ لهم أو تصمُتَ عن مجازرهم اليومية بحق بلد لمجرد رفضه الانصياع لهم، أو استدعاء رئيس حكومة وإجباره على تلاوة بيان يدعو فيه لقيام حرب أهلية أو تقديم أرضك هبة لشذاذ الآفاق من الصهاينة. هذا عالم عليك أن تجاريَ فيه من تهدّدك نُخَبُه بإبادة شعبك كاملاً؛ بسَببِ خلافاتك معها، ويحركها الحقدُ الأعمى والبحث عن النكاية مهما كان ثمن ذلك عليها (دعوات في «تويتر» لإلقاء القنابل النووية في المدن الإيرانية الرئيسية تأديباً للإيرانيين والصحافي محمد آل الشيخ يذكّر أن هناك جانباً مشرقاً في اندلاع مواجهة مدمّـــرة في بحيرة الخليج، وهو أن قطر لن تتمكن من استضافة بطولة كأس العالم المقبلة).
ولا يقف بيننا وبين الرضوخ لهذا العالم سوى جماعات اكتوت بنار هذا العالم وتعرفُ أن المواجهة معه لا بد منها، وأنه مهما كانت كلفة هذا الخيار فهي أقل من كلفة خيار الاستسلام والتنازل، وهي لا تشاطر المنظومة الرسمية مصادر القوة، وتتبنى خطاباً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، يثير سخرية القوى الأُخْـــرَى ممن تعاديها؛ لأَنَّها لا تجرؤ على الوقوف مثل مواقفها، أساسه مفاهيم، مثل: القدرة الإلهية غير المحدودة، تحمّل المسؤولية، نبذ التنصل من الواجب، تحرير فلسطين وزوال إسرائيل، تحديد أميركا عدواً تقع المعركة معه على كُـــلِّ الأصعدة، الحزم مع التخطيط المحكم، الاعتماد على النفس والكرامة أولاً وآخراً. وهو خطابٌ، أساساً، تطور بشكل جدلي في سنين طويلة بالتوازي مع تجربة مرّة خاضوها في الواقع، خبروا فيها كُـــلّ أنواع المحن والتحديات التي يمكن أن تواجه مجتمعهم، من محاولة الإجهاض قبل الولادة والاستعداء في المحيط المحلي والدولي والخيانات والطعن في الظهر والمناورات السياسية؛ ليخرجوا من كُـــلّ تحدٍّ أقوى مما كانوا عليه وأطول يداً وأزيد طموحاً في أهدافهم، وأشد مراساً على استخدام السلاح وأدوات الدفاع عن النفس.
مؤخراً كان هناك اجتماعان مهمّان على المستوى العربي والإسْـــلَامي، وكلاهما استخدم عناوينَ دينيةً؛ دفاعاً عن مقدساته: الأول في مكة بمنصة رسمية خلفيتها قطعة من كسوة الكعبة دفاعاً عن النفط، والثاني في شوارع مدن مختلفة وبحضور ملايين دفاعاً عن القدس وقضية فلسطين. المثير في الأمر هنا هو أن أميرَ النفط -كما يسميه الشاعر اليمني عبدالله البردوني في أحد قصائده- مهما رفع من عناوينَ دينيةٍ ومقدَّسة لاستغلال المشاعر فإنه يعرفُ مصدرَ أهميته وحقيقته من دونها، وهو من هذه الناحية يتفقُ مع البردوني في قصيدة أُخْـــرَى يصف فيها أحوال عدوه السعودي بين الماضي والحاضر فيقول:
خصمُنا اليومَ غيرُه الأمس طبعاً
البراميلُ أمرَكت شيخَ ضَبَّه
عندَه اليوم قاذفاتٌ ونفطٌ
عندنا موطنٌ، يرى اليوم دربَه
عنده اليوم خِبرةُ الموت أعلى
عندنا الآن، مهنةُ الموت لُعبه
صار أغنى، صرنا نرى باحتقارٍ
ثروة المعتدي، كسروال (…..)
صار أقوى.. فكيف نقوى عليه
وهو آتٍ؟ نمارس الموتَ رغبه
يصعُبُ الثائرُ المضحي ويقوى
حين يدري، أن المهمة صعبه
* كاتب عربي- الأخبار.