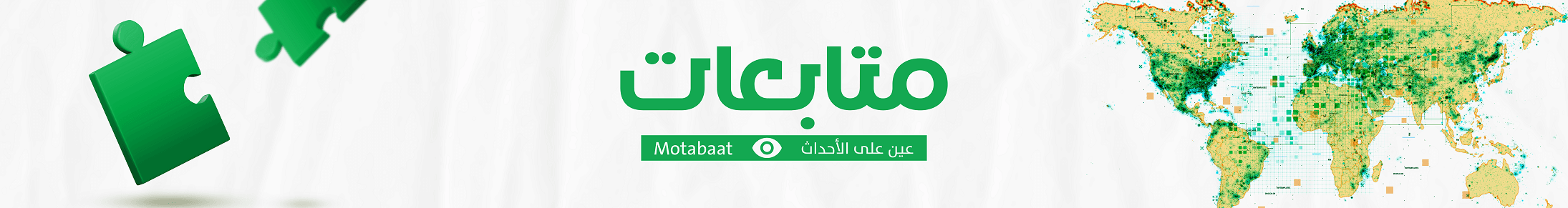الإمارات في سقطرى: إعمار أم استعمار؟ “مقالة تحليلية”

متابعات| العربي| عبد الله سعيد:
وفي الفترة الأخيرة، وفي إطار الحرب الذي يشنها «التحالف» بقيادة السعودية، وعضوية الإمارات والبحرين ومصر والسودان، مناصرة للرئيس عبد ربه منصور هادي ضد «أنصار الله» وحلفائها، توسع النفوذ الإماراتي في مناطق جنوب اليمن ومنها جزيرة سقطرى. وترد الكثير من التقارير الصحافية والتسريبات والكتابات التي تتحدث عن طبيعة هذا الدور، ففي حين يرى بعضها أنه دور إيجابي يتمثل في حماية «الشرعية» اليمنية وتقديم الخدمات للمواطنين والعمل على تحسينها والاهتمام بالناس والبيئة والحياة الطبيعية هناك، يرى آخرون أنه نوع من الإحتلال والسيطرة على الأرض ونهبها واستغلالها. وبين هذا وذلك، نحاول في هذا التقرير أن نقترب من طبيعة هذا الدور والتعرف على أهم ملامحه، وإن كانت هناك صعوبة بالغة في بحث غمار هذا الأمر المحاط بالسرية والكتمان.
ترتبط جزيرة سقطرى بالإمارات بعلاقات قديمة منذ عشرات السنوات، وهناك ترابط أسري بين كثير من الأسر في الإمارات وسقطرى. كما أن السقطريين منذ القدم يحظون بتعامل خاص من قبل الدولة الإماراتية، ولديهم مناصب حكومية وموظفون في الأمن والشرطة والجيش، بالإضافة إلى الترابط التجاري، حيث كانت البضائع تصل مباشرة من دبي والشارقة إلى سقطرى، في حين يتم تصدير بعض المنتجات السقطرية المحلية إلى الإمارات. كذلك، افتتحت الإمارات بعض المشاريع الخدمية في الجزيرة لعل أهمها مستشفى خليفة، وهو المستشفى الوحيد هناك، وتم أيضاً بناء مدينة للأيتام في حديبو على نفقة مؤسسات خيرية إماراتية، وفي الوقت نفسه برزت ملامح حركة استثمار إماراتية في هذه المجالات منذ أكثر من خمس سنوات.
لقد كان تواجد الإمارات قبل الحرب ماثلاً للعيان عبر العمل الخيري الرسمي أو عبر مؤسسات خيرية، وقد زاد هذا العمل أثناء هذه الحرب الأخيرة، مع بروز دور الهلال الأحمر الإماراتي، حيث تم تقديم الكثير من المساعدات للمواطنين، ودعم الخدمات الأساسية لاسيما في المجال الصحي. إن الدور الإماراتي في هذا الجانب ملموس من قبل المواطن، ولكنه غير كاف، فما زالت الأجواء مغلقة أمام الملاحة، والمنفذ الوحيد للسكان هو البحر المليء بالمخاطر التي كان آخرها غرق مركب يقل ستين راكباً أواخر العام الماضي، كما أن هناك تدهوراً فظيعاً في الخدمات التعليمية، وكذلك الكهرباء والمياه.
لقد ارتبط الإستثمار في سقطرى بشخصيات غامضة، لا أحد يعلم مدى صلتها بالجانب الرسمي في دولة الإمارات، وما إذا كانت مجرد شخصيات نافذة أم لها ارتباط بالجهات الرسمية. فـ«أبو طارق» يُعرف بكنيته فقط، هذا كل ما يعرف عن هويته أهل سقطرى، لكنهم أيضاً يعرفون أنه الوسيط لتمويل بعض المشاريع الخيرية، وهو في الوقت نفسه صاحب مشاريع استثمارية وشراء أراض على شواطئ سقطرى الهامة، وكذلك في منطقة دكسم المحمية الطبيعية حيث يوجد أكبر تجمع لأشجار دم الأخوين، الأشجار النادرة التي تتفرد بها سقطرى عن بقية مناطق العالم.
سقطرى منطقة يتسم أهلها بالسلمية والطيبة والتلقائية والحياة البسيطة، وقد جاءت هذه الحرب لتلقي بظلالها وتعمل على صنع بؤر صراع يمكن أن يتحول إلى صراع مسلح داخل الجزيرة التي لم يعرف أهلها الصراع من قبل. فبالإضافة إلى وجود عناصر مسلحة مدعومة من قبل حزب «الإصلاح»، عملت الإمارات على تجنيد ما يقارب 2000 شخص أغلبهم من عناصر الحراك الجنوبي، كما عملت على تدريب أكثر من 700 عنصر من أبناء الجزيرة وأدمجتهم في اللواء الأول مشاة بحري، وهو اللواء العسكري الوحيد المرابط في الجزيرة، كما عملت على الدفع بعناصر سقطرية تابعة لها إلى محاولة الإنقلاب ضد محمد علي الصوفي، قائد اللواء التابع لهادي، كما كشف «العربي» سابقاً. هذه المحاولات للسيطرة التامة على الجانب العسكري صاحبها دعم للقوات الموجودة، حيث تم في مايو 2016 تسليم أكثر من 80 سيارة عسكرية، بالإضافة إلى الإسهام في دفع رواتب العسكريين وإن تم استثناء العناصر العسكرية الشمالية في هذا اللواء.
«أبو مبارك»، لا يعرف السقطريون غير هذا الإسم، فهو تقريباً الحاكم الفعلي لجزيرة سقطرى، لا يوجد له اسم ولا هوية واضحة، ولا يمكن للإعلام أن يتعرف عليه، تماماً كما هو الأمر في حضرموت، فلا يعرف الناس هناك سوى «أبو سيف». لقد أطبقت الإمارات سيطرتها على الميناء والمطار، وهما المنفذان الوحيدان للتواصل بين سقطرى والعالم، وقد تم الإستغناء عن العناصر السابقة من الأمن والمخابرات والإتيان بعناصر جديدة على ارتباط بالقيادة الجديدة. كل هذه التغيرات التي جاءت بعد 2015، وهو العام الذي بدأت فيه الإمارات محاولة بسط نفوذ جديدة على الجزيرة، صاحبها عمل على التقرب من رجال العشائر ودعمهم بالمال والسيارات الحديثة.
يعاني المواطن في سقطرى من تدهور الجانب الإقتصادي، في ظل عدم وجود أي موارد. وفي الوقت نفسه، لا يوجد أي نظام ضريبي أو جمركي يمكن أن يعود بالنفع على الوضع العام في سقطرى. وترد اتهامات بأن هناك اصطياداً جائراً للأسماك في شواطئ سقطرى دون أن يكون هناك أي عائد للجزيرة، كما أن هناك استثمارات في الأحياء البحرية ولكن بدون أن يكون هناك أي فوائد لسقطرى. ثمة أخطار حقيقية تتهدد الطبيعة في الجزيرة، لاسيما تهديد الغطاء النباتي الناتج من أمرين: الأول الاحتطاب الذي يسببه عدم توافر غاز الطبخ، والآخر معامل الفحم الذي يصدر إلى الإمارات، ولكن هذا الأمر ليس له علاقة مباشرة بالسيطرة الإماراتية، فهو قائم منذ سنوات، وكان ينبغي على السلطات أن تحد من هذا الفعل الذي سيتسبب بكارثة تخرج سقطرى من تصنيفها العالمي. والأمر نفسه بالنسبة إلى الأحجار التي يتم تصديرها دون وجود أي ضوابط أو شروط أو معايير، ودون أي مردود اقتصادي للجزيرة ككل.
إن من أهم ملامح السيطرة الإماراتية خارج حدود حماية «الشرعية» هو وجود شبكة اتصالات خاصة. هذه الشبكة إماراتية، وتعمل بشرائح إماراتية، كما يتم بيع كروت اتصالات للشحن في سقطرى، وقد تم تزويدها بخدمة الإنترنت «3 جي»، وتعمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساء للمواطنين، ويتم إقفال الشبكة ولكنها تظل مفتوحة لمن يريدون من المستخدمين.
لا ينكر الناس في سقطرى وجود مساعدات إماراتية، ولكنها خير فاعلة، كما أن المستفيد الأكبر هو بعض المتنفذين ورجال العشائر وبعض المسؤولين المتعاونين معهم. حتى السيارات التي تم توزيعها ذهبت إلى بعض المسؤولين في الجهات الحكومية ولم تذهب إلى آخرين. كما أن الدعم في أغلبه لم يأت من الجهات الحكومية وإنما من مؤسسات خيرية إماراتية قد يكون بعضها متعاوناً مع الدولة. هذا هو الدور الإماراتي في سقطرى، ما يزال غامضاً وغير محدد الملامح بشكل حاسم، غير أن الواضح هو أنه وجد فراغاً سلطوياً فادحاً فحاول أن يملأه بما يتوافق مع سياسة الإمارات الخارجية الجديدة في المنطقة والعالم.