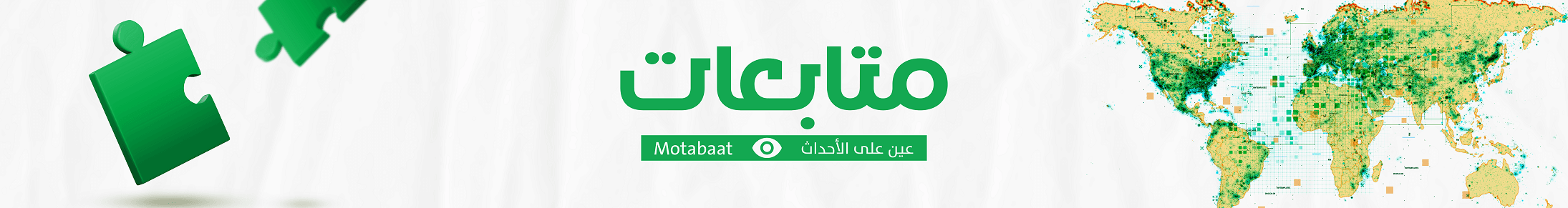تحليل| الصراع على الوكالة الأمريكية.. ماما أمريكا” تصلح بين “الأشقاء”

التباين بين الولايات المتحدة من جهة على مستوى الأولويات والمحددات السابق ذكرها هنا، يقابله تباين وخلافات بين دول ما كان يسمى بـ “محور الاعتدال”؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر شهدت العلاقات المصرية السعودية على مدار العامين الماضيين خلافات علنية حادة بين القاهرة والرياض على خلفية موقف الأولى تجاه حجم مشاركاتها في حرب اليمن، الذي اعتبرته الثانية تخاذل ونكران لجَميل المساعدات المالية التي أغدقتها عقب الثلاثين من يونيو 2012، وهو ما ينسحب أيضاً على موقف مصر من السياسات السعودية تجاه سوريا والتقارب بين المملكة وأنقرة على حساب القاهرة، وما تبع ذلك من ضغط سعودي لإجراء مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين.
أعقب ذلك أزمة نتجت عن تعطيل تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين وتسليم جزيرتا تيران وصنافير للسعودية بأحكام قضائية. وأخيراً التحفظ السعودي على توسيع التعاون العسكري بين مصر وروسيا من البوابة الليبية والذي من وجهة نظر سعودية تم بشكل مستقل عنها أدى إلى خسارتها لورقة مساومة كان يمكن أن تستخدمها المملكة مع موسكو في إطار أكبر حول تمكين الأخير بحصة أكبر في المنطقة مقابل تخلي الأخيرة عن دعم الحكومة السورية وحلحلة موقفها في الأزمة السورية بشكل عام. وهو ما أدى إلى تأزم علني غير مسبوق طيلة العقود الأربعة الأخيرة بين البلدين مارست فيه المملكة سياسات عقابية أخطرها وقف بيع النفط للقاهرة أكتوبر الماضي، ثم استئنافه أمس بالتوازي مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن ولقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
تهدئة أمريكية للخلاف بين المشير والأمير
وجدير بالذكر أن الرياض مارست ضغوطاً على القاهرة طيلة العاميين الماضيين لإنفاذ شروط استمرار دعمها المادي لمصر، بما في ذلك إرسال قوات للخارج وعقد مصالحة مع الإخوان، إلا أن المملكة صعدت من هذه الضغوطات لمستويات غير مسبوقة بداية من الربع الأخير من العام الماضي، ويمكن حصرها في الضغوط الاقتصادية الممثلة بقطع الدعم عن مصر وتأزيم موقف النظام وشعبيته في الداخل عن طريق خلق أزمات في الطاقة والوقود، وضغوط سياسية ممثلة في تأليف معارضة مصرية برعاية سعودية في الخارج ليست حصرية لجماعة الإخوان، وأمنية متعلقة بشكل رئيسي بملف سد النهضة الأثيوبي ودعم السعودية لبنائه والاستثمار فيه، وكذا دعم موقف الخرطوم ودفعه لتدويل مسألة حلايب، التي تدعم الرياض الخرطوم فيها بشكل علني ومباشر، وذلك كرد على “التلكؤ” المصري في الاستجابة للسعودية في مختلف الملفات، وعدم تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود، وكذلك التقارب المصري-الروسي على مستوى عسكري، والذي ضرب خطط السعودية لمساومة روسيا على حيز من النفوذ في المنطقة –بتصريح وزير الخارجية السعودي في النصف الثاني من العام الماضي– بتوفير القاهرة له من خلال تعزيز التعاون الأمني والعسكري بينها وبين موسكو والذي بدأ بمناورات «حماة الصداقة»، ونهاية بأحاديث “غير رسميه” عن تواجد قوات مصرية في سوريا تحت مظلة التعاون المشترك مع روسيا الممتد إلى ليبيا. وأخيراً سلوك القاهرة المنفرد في تعزيز العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة –المناهضة سلفاً للمملكة- بمعزل عن فرضية قيادة المنطقة من قبل السعودية وتصدير تلك الصورة لواشنطن، ورفض مصر لهذه الصيغة التي تنقلها من حيز شريك وحليف المملكة إلى حيز التبعية للقرار السعودي.
بدائل خطرة!
وبالأخذ في الاعتبار محدد هام من المحددات السابق ذكرها، وهو تعويض دول “الاعتدال” الانكماش الأمريكي بمحاولات تكوين تحالفات تكتيكية بين بعضهما، وأيضاً بالانفتاح على قوى دولية أخرى دون التخلي عن علاقاتها الإستراتيجية مع واشنطن، وجدت الأخيرة أن الأفضل هو تصفية الخلافات بين حلفائها ليس فقط لضمان وحدة صف حلفائها التي ستعتمد عليهم في سياسة الإدارة دون تدخل مباشر، ولكن أيضاً لأن عدم مبادرة الإدارة الأمريكية لاتخاذ هذه الخطوة قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالإستراتيجية ككل وبمضاعفات تتجاوز ضرر عودة التدخل المباشر.
فمثلاً لجوء بعض من حلفاء الولايات المتحدة لهذه التحالفات التكتيكية مع روسيا قد يخلق فرص للمناورة قد تتطور إلى محاولات بعض من هذه الدول لتغليب رؤيتها حسب أولوياتها المُلحة لا أولويات واشنطن؛ وأبرز الحالات التي من المحتمل إذا ما استمرت الإدارة الأمريكية الجديدة بسياسة سحب يدها من حل خلافات حلفائها هي توافق القاهرة وأبوظبي على دعم أحد أطراف الصراع الليبي وبوادر توافق بينهما وبين موسكو في هذا الشأن بعيداً عما تريده واشنطن في ليبيا، أو كما حدث في الحالة السعودية عقب التوترات التي شهدتها علاقاتها مع واشنطن خلال العاميين الماضيين وحالة التخبط التي سادت سياسات الرياض بشكل عام إثر الانكماش الأميركي في المنطقة، والتي عوضتها المملكة بتوطيد تحالفها مع تركيا المتوافقة مع السعودية بشأن سوريا، والمختلفة مع الولايا المتحدة في نفس الشأن.
السابق سواء من حيث إذا تناقض مع المصلحة الأمريكية أو من جهة إجهاض محاولة للتنسيق بين واشنطن وموسكو على غرار التفاهم المشترك في سوريا –بغض النظر في سياقنا هنا عن مألاته- حول ليبيا، والذي من شبه المؤكد أنه سيفشل وسيؤدي للمزيد من التداعيات السلبية للولايات المتحدة في حالة تعزز التوافق بين حلفاء واشنطن –مصر والإمارات- وأطراف معنية بالشأن الليبي مثل الجزائر وموسكو حول ليبيا بعيداً عن الإطار التوافقي المرجح بحثه بين الكرملين والبيت الأبيض في نفس الأمر.
الخيار الأسهل.. أمريكياً
في هذا السياق، نشرت الباحثة المتخصصة في السياسات الروسية في الشرق الأوسط، آنا بورشفسكيا، مقالاً لها في صحيفة “زا هيل” الأمريكية، تناولت فيه أفق الدور الروسي في ليبيا، ومدى صحة إيجاد مساحات من التعاون بين موسكو وواشنطن حسب تلاقى أو تنافر أولويات القوتين العظمتين هناك، وعلاقة هذا الأمر بالإدارة الأمريكية الجديدة التي صرح رئيسها أكثر من مرة عن فرص تعاون إيجابية بين بلاده وبين روسيا في مختلف الملفات والقضايا وعلى رأسها مجابهة تمدد تنظيم داعش في المنطقة بعد هزيمته المزمعة في سوريا والعراق. وعلاقة السابق بتلافي استقطاب إقليمي جديد مدعوم كل طرف فيه من أحدى الدولتين حول ليبيا على غرار ما حدث ويحدث حتى كتابة هذه السطور في سوريا. فرأت الباحثة أن “ترامب اعتاد ترديد أنه من الممكن أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حليفاً قوياً في الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا، ولكن في حين تتركز معظم الأنظار على سوريا في هذا السياق، إلا أن ليبيا هي مكان آخر يجب متابعته عن كثب في الأسابيع المقبلة. فيزداد دعم الرئيس بوتين شيئاً فشيئاً لحفتر الذي يتحكم بشرق البلاد الغني بالنفط ولكن يسعى للمزيدوهنا يمكن لترامب وبوتين التوصل إلى اتفاق (..) من جهتها تدعم مصر جهود بوتين في ليبيا، ولطالما كانت الجزائر في المعسكر المؤيد للكرملين. ويعتقد السيسي أن حفتر سيمنع جماعة الإخوان المسلمين من الحصول على موطئ قدم في ليبيا كما ويتفق عموماً في الرأي مع بوتين عندما يتعلق الأمر بتدابير مكافحة الإرهاب”.
وإذا وضعنا ما طرحته بورشفسكيا بجانب ما ذكره الأدميرال المتقاعد، جيمس ستافريديس، عميد كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس الأمريكية، وأحد مستشاري البنتاجون في مقال له نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية الشهر الماضي أن: “سلسلة المحادثات الأخيرة التي جرت بين خبراء الدفاع الأميركي والحكومة المصرية، قد أظهرت العديد من الموضوعات الرئيسية التي ترسم فكر الحكومة المصرية هي كالتالي: أولاً: ترى مصر نفسها بمثابة مرتكز استقرار الشرق الأوسط وأمنه. كما أن المنهج الرئيسي للحكومة المصرية، والمكونة من فريق من التكنوقراط الذين جمعهم السيسي، هو الأمن قبل الكمال، ما يعني أنها ستحاول تحسين حقوق الإنسان، إلا أن أولويتها الرئيسية تبقى ضمان الأمن اليومي في الشوارع والتخلص من الإرهاب. وأن مصر ملتزمة بعلاقتها مع إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أنها ستسعى للبحث عن شركاء إضافيين غير تقليديين”. وهو يرى ستافريديس أنها “تخلق مساحة عمل مشترك بين واشنطن والقاهرة يمكن أن تحقق مصلحة الأولى بقليل من المجهود والدعم حيال مختلف أولويات السياسة المصرية في الداخل والخارج والتي لا تبتعد كثيراً من وجهة نظره عن أولويات الولايات المتحدة تحت حكم ترامب”.
وكاستنتاج أخير يربط هذه المشاهد المتناثرة في الصورة الكاملة، نجد أنه من المرجح أن إدارة ترامب بدأت بالفعل في لعب دور في إنهاء الخلافات بين “وكلائها”، ليس فقط عبر الدلالات السابق ذكرها على مختلف الأصعدة والساحات، ولكن عبر مؤشر هام متمثل في استئناف بيع آرامكو اسعودية النفط لمصر عقب لقاء محمد بن سلمان –المسيطر مؤخراً على الشركة العملاقة- وترامب أمس، والذي يُعد خيار أميركي آمن بعيداً عن شطط وتعنت قد يؤدي إلى تطوير العلاقات المصرية الإيرانية عبر بوابة النفط العراقي – البديل عن توقف النفط السعودي- أو حتى بديل عن النفط الليبي الذي كان ستؤمنه القاهرة بمزيد من الدعم والتصرف المنفرد في ليبيا بمعزل عن التنسيق مع واشنطن وبالتحالف مع موسكو، وهو ما جعل الإدارة الأمريكية تتدخل لاستئناف تعاقد توريد النفط السعودي من موقع النصح والمصلحة المشتركة بينها وبين كل من القاهرة والرياض. وبالتالي نجد أنه من الأيسر والأفضل على الإدارة الأمريكية التدخل لحل الخلافات بين حلفائها على أن تتركهم يقوموا بتسويتها بأنفسهم وبخيارات قد تضر المصلحة الأمريكية، خاصة وأنه كان ولازال هناك “إلحاح” من دول “الاعتدال” الحليفة وعلى رأسها السعودية ومصر على ضرورة تدخل أميركي ينهي التباينات بينهم ويضبط بوصلة سياستهم الخارجية لتتسق مع السياسية الأمريكية في المنطقة.